كتبت قبل نحو أسبوعين في “درج” مقالة تساءلت فيها عن المنصب الذي يشغله الشرع، وقلت إنه مدين للسوريين بأن يتحدث إليهم. قلت: “نحن – الشعب – نريد أن نسمع من الحاكم الفعلي لسوريا، ومنه مباشرة في خطاب إلى السوريين، لا الترك ولا الغرب ولا العرب ولا الإسلاميين. ونريده حديثاً مباشراً من العقل والقلب، من دون فلترة أو تزويق، فنسمع فيه رؤية الشرع الحقيقية عن مستقبل سوريا وقضايا الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ومسائل الحريات العامة والمواطنة المتساوية ودور النساء، وغير ذاك.
نريد أن نعرف ماذا يقصد الشرع بالمؤتمر الوطني وما شروط المشاركة فيه، ولماذا تحتاج كتابة الدستور الى سنوات والانتخابات الى سنوات؟ وهل ستُجرى الانتخابات في ظل إشراف دولي أم لا، وكيف سيطبق مبدأ العدالة الانتقالية، وكيف سيبني الاقتصاد لتقف البلاد على رجليها وتنتفض كطائر الفينيق السوري، من الرماد”.
لبّى الشرع (مجازاً) مطلبيّ الاثنين، فعيّن نفسه رئيساً للبلاد، وتحدث إلى السوريين للمرّة الأولى منذ سقوط النظام وفرار الأسد المهين. لا أحد يمكن أن يؤكد إذا كان تعيين الشرع رئيساً مخططاً له أم لا. غالب الظن أن الخطوة جاءت بسبب تعثر عقد مؤتمر وطني شامل واقتراب فترة الحكومة المؤقتة من نهايتها. وغالب الظن أيضاً أن الشرع سيشكل مجلساً تشريعياً على قده ويكلف البشير بتشكيل حكومة انتقالية جديدة.
في وجه واحد على الأقل، ذكّرني خطاب الشرع بخطاب الرئيس المخلوع في 30 آذار/ مارس 2011، فكلا الخطابين كان قصيراً، ولم يشبع حاجتنا الى المعرفة، ولم يجب عن أسئلتنا. ولكنهما مختلفان في مناحي شتى. والحق أنني استمعت الى خطاب الشرع مرتين، وتأنيت في قراءته، كي لا أقع في غرامه أو أتحامل عليه. ووجدت الخطاب معتدلاً وأفضل مما كنت أخشى.
سأبدأ بما أتفق مع الشرع فيه. أحببت في الخطاب عدم احتكار النصر لنفسه أو جماعته، ونسْبه الفضل لنضالات جميع السوريين، وأحببت إردافه السوريات بالسوريين والمعتقلات بالمعتقلين، وأحببت استخدامه عبارة “خادم للشعب،” وهو تعبير ما كان بالإمكان سماعه من صبي متعجرف من آل الأسد، وأحببت ذكره العدالة الانتقالية، التي تفترض العدالة ومنع الإفلات من العقاب، ولكن من دون الثأر.
الأولى تمَنُّعه عن ذكر كلمة الديمقراطية ولو لمرة واحدة في خطابه، والاستبدال بها كلمة “شورى”. ولا أحسب أنه قد غفل عن ذلك، بل أعتقد أنه إنما ينسجم مع عقيدة رافضة لمبدأ الديمقراطية بحكم الشعب نفسه بنفسه، والاستناد إلى مبدأ ضبابي، لا ضوابط له، مثل مبدأ الشورى.
وردت فكرة الشورى في القرآن مرتين فقط، الأولى: “والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون”. (الشورى 38) والثانية، ” فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فاذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين”. (آل عمران 159)
ولو تأمّلنا في الآيتين بتجرّد وموضوعية، لما وجدنا في أي منهما معنى الديمقراطية. في الآية الأولى، لا يتحدث النصّ عن الحكم أو السياسية، بل يتحدث السياق عن الحياة الدينية والاجتماعية، كما هو واضح من الآية التي تسبقها أو تليها. فالآية التي تسبقها تقول: “والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون”. والآية التي تليها تقول: “والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون”. إذاً لا معنى للاستشهاد بهذه الآية لتأكيد أن النص القرآني يقوم على الشورى في السياسة والحكم.
الآية الثانية، في المقابل، يمكن أن ترد في سياق سياسي. ووفق ابن كثير، فإن النبي كان يشور المسلمين ويأخذ برأيهم أحياناً. ومع ذلك، الآية واضحة لا لبس فيها. أولاً هي طريق ذو اتجاه واحد، فالنبي (أو الحاكم) هو الذي يستشير الناس، ولكن الناس لا تشير عليه من دون أن يطلب منها ذلك. وهي ثانياً ليست وسيلة لاختيار الحاكم. وهي أخيراً ليست ملزمة، إذ سرعان ما يضيف النص القرآني مباشرة بعد “وشاورهم في الأمر” عبارة “فإذا عزمت فتوكّل على الله”. ووِفق ابن كثير، لما نزلت هذه الآية قال النبي: “أما أنّ الله ورسوله لغنيان عنها، ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي، فمن استشار منهم لم يُعدم رُشداً ومن تركها لم يُعدم غيا”.
والنقطة الثانية التي أختلفُ فيها مع الشرع هي الطريقة التي وصف فيها مؤتمر الحوار الوطني. إذ قال إن الحكومة ستعلن “في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم”. أعتقد أن هذا الوصف ناقص. فبينما سيكون المؤتمر منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر، فهو أيضاً المكان الذي ستتحدّد فيه الأسس الذي ستقوم عليه سوريا القادمة. مؤتمر الحوار ليس ندوة ثقافية أو فكرية، بل هو هيئة سيادية معنية بوضع الأسس الدستورية والسياسية لسوريا المستقبلية، ومهمته ليست استشارية (شورى؟) بل مؤسسة للسلطات الثلاث والفصل بينها. ولا أحسب أن الشرع قد سها عن ذلك، ولكن التغاضي عنه ينسجم مع سياسته غير المعلنة، والقائمة على “أننا سنسمع منكم، فإذا عزمنا سنتوكل على الله”.
النقطة الثالثة هي أن الشرع، على الرغم من اعترافه بدور الجميع في تحقيق النصر، من حمزة الخطيب إلى الفصائل التي دخلت دمشق فاتحة، قصر مؤتمر النصر على الطرف الأخير فحسب. وهذا إن دلّ على شيء، فعلى رغبة الزعيم الجديد في تنفيذ رؤيته هو ومن يواليه ويواليهم، وليس “كل السوريين والسوريات في الداخل والخارج لبناء مستقبلهم بحرية وكرامة من دون إقصاء أو تهميش،” كما وعد في كلمته.
خير ما يمثلنا، نحن معشر السوريين من دعاة الدولة المدنية والعلمنة والديمقراطية وحقوق الإنسان عبارة “ظاهرة صوتية” التي اجترحها في السبعينات عبد الله القصيمي. اعتبر القصيمي أن الخطاب العربي ينوء تحت وطأة الشعارات والمفردات الرنانة التي تعبّر عن القوة والطموح، ولكنه يفتقر إلى الممارسات العملية أو القدرة على تحويل الأفكار إلى واقع.
وبينما لم يكن القصيمي طبعاً يخص المثقفين العلمانيين، ولكن هذا الوصف هو خير ما يميز العلمانيين، فهم يكتفون بالإشارة إلى الخطأ، من دون أن يُعنَوا بذكر الصواب، وهم يمتنعون عن سلوك سبيل معين، من دون أن يقترحوا طرح السبيل الآخر. العلمانيون السوريون، معظمهم، يكتفون بالانتقاد، من دون أن يطرحوا بديلاً أو سبيلاً سوى السبيل المطروح أمامنا. وخير ما يشرح الفكرة مَثل سوري دارج، يقول: “من لا يحضر ولادة عنزته، تخلّف له جروا”.
هل ثمة قوى سورية ديمقراطية علمانية حقيقية؟ نعم، لكنها مشتّتة وخَمول وشخصانية. نحن ناشطون جداً في القول ولنا صوت عال، ولكنه فارغ من أي محتوى، لأنه لا يستند إلى بشر حقيقيين، إلى سوريين يؤمنون بذلك ويناضلون في سبيل تحقيقه. فهل من العدل أن نقول إنه لا يوجد بالفعل سوريون يؤمنون بالديمقراطية والعلمانية؟
أحب أن أجيب عن السؤال بلا. فبين السوريين بالفعل شرائح عريضة تبتغي حكماً ديمقراطياً مدنياً، لأن في ذلك إحقاقاً للحق وضماناً لأنفسهم وحماية لمجتمعاتهم واحتراماً لتاريخ سوريٍّ عريق، يعود إلى ما قبل انقلاب البعث وحكم آل الأسد، ومتأصّلة في دساتير 1920 و1930 و1950، التي تحدّد جميعها ديانة رأس الدولة، من دون أن تحدّد ديانة الدولة نفسها، وتعتمد سيادة الشعب عبر مجالسه المنتخبة التي تسنّ القوانين والقرارات الملزمة.
وببعض التفصيل الذي لا بدّ من أن يصطبغ ببعض الطائفيّة، فإنني أعتقد أن جزءاً كبيراً من سنّة المدن وحوران يضافون إلى معظم المسيحيين والعلويين والدروز والإسماعيليين والكرد سيرغبون في نظام كهذا، يحمي حرياتهم وحقوقهم ويحميهم مما اسماه ألكسيس دي توكفيل “طغيان الغالبية” واعتبره واحداً من أخطر التهديدات التي تواجه الأنظمة الديمقراطية.
لكن، كيف بإمكان هذه النسبة الكبيرة من السوريين أن تشكّل رأياً عاماً ضاغطاً في غياب قوى سياسية ديمقراطية حقيقية ومؤثرة تمثّلهم وتقودهم وتتحدّث باسمهم؟
سيتعين على الشرائح الديمقراطية المدنية والعلمانية في سوريا، أن تعمل من دون تمثيل، ولعلّها تستهدي بهدي الفيلسوف والعالم السياسي الإيراني آصف بيات الذي تحدث عن هذه الحالة.
في كتابه ” الحياة كسياسة: كيف يغيّر الناس العاديون الشرق الأوسط”، يقدم آصف بيات منظوراً رائداً للتغيير الاجتماعي والسياسي في المنطقة. وخلافاً للتحليلات التقليدية التي تركز على الحركات المنظمة أو الثورات أو سياسات النخبة، يحوّل بيات العدسة إلى فاعلية الناس العاديين الذين يعيدون تشكيل مجتمعاتهم من خلال الممارسات اليومية. ويتحدى مفهومه المركزي “اللاحركة” Nonmovement كنقيض للحركيات السياسية Political movements المفاهيم التقليدية للنشاط السياسي، مقدماً رؤية دقيقة لكيفية حدوث التغيير في السياقات الاستبدادية والمقيّدة.
ويرى بيات أن الحركات غير الحركية فعالة بشكل خاص في السياقات التي يُقمع فيها النشاطُ العلني. فهي تعمل من خلال ما يسميه “التعدي الهادئ للعاديين،” وهي عملية يطالب فيها الأفراد المهمشون بالحقوق والمساحة والموارد من دون مواجهة الدولة مباشرة. فالباعة المتجولون الذين يحتلون الأماكن العامة، والنساء اللاتي يتحدين قواعد اللباس التقييدية من خلال التحدي الخفي، والشباب العاطلون عن العمل الذين يستعيدون المساحات الحضرية كلها أمثلة على ديناميكيات اللاحركة.
يطبّق بيات نظريته على مجموعات اجتماعية مختلفة، ويوضح كيف تؤدي أفعالها التي تبدو غير سياسية إلى تحولات مجتمعية عميقة. وهو يدرس مواضيع من مثل كيف يعيد الباعة المتجوّلون والمستوطنون والعاطلون عن العمل تشكيل الحياة الحضرية من خلال الاستقرار والعمل في الأماكن بشكل غير رسمي رغم القيود الحكومية.
ويركز بيات على النساء في الشرق الأوسط، ويرى فيهن قوة للتغيير المجتمعي، من خلال نضالهن الذكي ضد المعايير الأبوية من خلال المقاومة اليومية بدلاً من الحركات النسوية التقليدية. وهو يعطي مكانة خاصة للنشاط الشبابي ويشرح كيف ينشئ الشباب في الأنظمة الاستبدادية مساحات من الحرية والتعبير عن الذات، غالباً من خلال وسائل ثقافية مثل الموسيقى والأزياء والشبكات الرقمية. وتسلط مقاربة بيات الضوء على فاعلية المحرومين من الحقوق، وتصوّرهم ليس كضحايا سلبيين، بل كفاعلين رئيسيين في التغيير يعملون ضمن قيود مجتمعاتهم.
جوهر القضية بالنسبة الى بيات هو انتقاده الميل إلى تطبيق الأطر التقليدية للثورة والنشاط المنظم على الشرق الأوسط، إذ يجادل أن التغيير في المنطقة غالباً ما يتبع مسارات مختلفة. وهو يرى أن الحركات غير الحركية تتحدى الفكرة القائلة بأن العمل السياسي الهادف يجب أن يكون دائماً صريحاً أو تصادمياً أو منظماً. بدلاً من ذلك، تُظهر هذه الحركات كيف يمكن للتحركات التدريجية واللامركزية أن تقوّض السيطرة السلطوية مع مرور الوقت.
في غياب حركة ديمقراطية مدنية منظمة في سوريا، لا يبقى أمامنا كسوريين سوى حراك “لا حركي،” غير مؤطر وغير منظم، تقوده قطاعات عريضة من سكان المدن والمجموعات الدينية والعرقية التي لا يمكنها التعايش مع أي نظام من لون واحد.
----------
درج
نريد أن نعرف ماذا يقصد الشرع بالمؤتمر الوطني وما شروط المشاركة فيه، ولماذا تحتاج كتابة الدستور الى سنوات والانتخابات الى سنوات؟ وهل ستُجرى الانتخابات في ظل إشراف دولي أم لا، وكيف سيطبق مبدأ العدالة الانتقالية، وكيف سيبني الاقتصاد لتقف البلاد على رجليها وتنتفض كطائر الفينيق السوري، من الرماد”.
لبّى الشرع (مجازاً) مطلبيّ الاثنين، فعيّن نفسه رئيساً للبلاد، وتحدث إلى السوريين للمرّة الأولى منذ سقوط النظام وفرار الأسد المهين. لا أحد يمكن أن يؤكد إذا كان تعيين الشرع رئيساً مخططاً له أم لا. غالب الظن أن الخطوة جاءت بسبب تعثر عقد مؤتمر وطني شامل واقتراب فترة الحكومة المؤقتة من نهايتها. وغالب الظن أيضاً أن الشرع سيشكل مجلساً تشريعياً على قده ويكلف البشير بتشكيل حكومة انتقالية جديدة.
في وجه واحد على الأقل، ذكّرني خطاب الشرع بخطاب الرئيس المخلوع في 30 آذار/ مارس 2011، فكلا الخطابين كان قصيراً، ولم يشبع حاجتنا الى المعرفة، ولم يجب عن أسئلتنا. ولكنهما مختلفان في مناحي شتى. والحق أنني استمعت الى خطاب الشرع مرتين، وتأنيت في قراءته، كي لا أقع في غرامه أو أتحامل عليه. ووجدت الخطاب معتدلاً وأفضل مما كنت أخشى.
سأبدأ بما أتفق مع الشرع فيه. أحببت في الخطاب عدم احتكار النصر لنفسه أو جماعته، ونسْبه الفضل لنضالات جميع السوريين، وأحببت إردافه السوريات بالسوريين والمعتقلات بالمعتقلين، وأحببت استخدامه عبارة “خادم للشعب،” وهو تعبير ما كان بالإمكان سماعه من صبي متعجرف من آل الأسد، وأحببت ذكره العدالة الانتقالية، التي تفترض العدالة ومنع الإفلات من العقاب، ولكن من دون الثأر.
3 نقاط خلافية
ولكنني سأتوقف عند نقاط ثلاث أختلف فيها معه.الأولى تمَنُّعه عن ذكر كلمة الديمقراطية ولو لمرة واحدة في خطابه، والاستبدال بها كلمة “شورى”. ولا أحسب أنه قد غفل عن ذلك، بل أعتقد أنه إنما ينسجم مع عقيدة رافضة لمبدأ الديمقراطية بحكم الشعب نفسه بنفسه، والاستناد إلى مبدأ ضبابي، لا ضوابط له، مثل مبدأ الشورى.
وردت فكرة الشورى في القرآن مرتين فقط، الأولى: “والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون”. (الشورى 38) والثانية، ” فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فاذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين”. (آل عمران 159)
ولو تأمّلنا في الآيتين بتجرّد وموضوعية، لما وجدنا في أي منهما معنى الديمقراطية. في الآية الأولى، لا يتحدث النصّ عن الحكم أو السياسية، بل يتحدث السياق عن الحياة الدينية والاجتماعية، كما هو واضح من الآية التي تسبقها أو تليها. فالآية التي تسبقها تقول: “والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون”. والآية التي تليها تقول: “والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون”. إذاً لا معنى للاستشهاد بهذه الآية لتأكيد أن النص القرآني يقوم على الشورى في السياسة والحكم.
الآية الثانية، في المقابل، يمكن أن ترد في سياق سياسي. ووفق ابن كثير، فإن النبي كان يشور المسلمين ويأخذ برأيهم أحياناً. ومع ذلك، الآية واضحة لا لبس فيها. أولاً هي طريق ذو اتجاه واحد، فالنبي (أو الحاكم) هو الذي يستشير الناس، ولكن الناس لا تشير عليه من دون أن يطلب منها ذلك. وهي ثانياً ليست وسيلة لاختيار الحاكم. وهي أخيراً ليست ملزمة، إذ سرعان ما يضيف النص القرآني مباشرة بعد “وشاورهم في الأمر” عبارة “فإذا عزمت فتوكّل على الله”. ووِفق ابن كثير، لما نزلت هذه الآية قال النبي: “أما أنّ الله ورسوله لغنيان عنها، ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي، فمن استشار منهم لم يُعدم رُشداً ومن تركها لم يُعدم غيا”.
والنقطة الثانية التي أختلفُ فيها مع الشرع هي الطريقة التي وصف فيها مؤتمر الحوار الوطني. إذ قال إن الحكومة ستعلن “في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم”. أعتقد أن هذا الوصف ناقص. فبينما سيكون المؤتمر منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر، فهو أيضاً المكان الذي ستتحدّد فيه الأسس الذي ستقوم عليه سوريا القادمة. مؤتمر الحوار ليس ندوة ثقافية أو فكرية، بل هو هيئة سيادية معنية بوضع الأسس الدستورية والسياسية لسوريا المستقبلية، ومهمته ليست استشارية (شورى؟) بل مؤسسة للسلطات الثلاث والفصل بينها. ولا أحسب أن الشرع قد سها عن ذلك، ولكن التغاضي عنه ينسجم مع سياسته غير المعلنة، والقائمة على “أننا سنسمع منكم، فإذا عزمنا سنتوكل على الله”.
النقطة الثالثة هي أن الشرع، على الرغم من اعترافه بدور الجميع في تحقيق النصر، من حمزة الخطيب إلى الفصائل التي دخلت دمشق فاتحة، قصر مؤتمر النصر على الطرف الأخير فحسب. وهذا إن دلّ على شيء، فعلى رغبة الزعيم الجديد في تنفيذ رؤيته هو ومن يواليه ويواليهم، وليس “كل السوريين والسوريات في الداخل والخارج لبناء مستقبلهم بحرية وكرامة من دون إقصاء أو تهميش،” كما وعد في كلمته.
أين القوى الديمقراطية؟
يسير الشرع بخطى واثقة، وهو يستند كما قلت في مقالتي السابقة، إلى قاعدته الصلبة المؤلفة أساساً من جمهور سنّي إسلامي، وإلى دعم تركيا والدول العربية وجزء لا يستهان به من الغرب. وهو بالتالي لا يأبه – إلا قولاً – لبقية السوريين من غير قاعدته. ولعلي لو كنت مكانه، لفعلت الشيء نفسه. فحين لا تجد أمامك من يعترض على ما تفعل، فلن تسعى أنت لتلبي رغباتهم نيابة عنهم. وأنا لا أعني بالاعتراض هنا، النشاط على فيسبوك ومجموعات واتسآب، فهذه لا تُغني ولا تسمن من جوع. قصدت بالاعتراض المعارضة المدنية الحقيقية القائمة على أسس سياسية منظمة، تعبر عن قوى اجتماعية محددة.خير ما يمثلنا، نحن معشر السوريين من دعاة الدولة المدنية والعلمنة والديمقراطية وحقوق الإنسان عبارة “ظاهرة صوتية” التي اجترحها في السبعينات عبد الله القصيمي. اعتبر القصيمي أن الخطاب العربي ينوء تحت وطأة الشعارات والمفردات الرنانة التي تعبّر عن القوة والطموح، ولكنه يفتقر إلى الممارسات العملية أو القدرة على تحويل الأفكار إلى واقع.
وبينما لم يكن القصيمي طبعاً يخص المثقفين العلمانيين، ولكن هذا الوصف هو خير ما يميز العلمانيين، فهم يكتفون بالإشارة إلى الخطأ، من دون أن يُعنَوا بذكر الصواب، وهم يمتنعون عن سلوك سبيل معين، من دون أن يقترحوا طرح السبيل الآخر. العلمانيون السوريون، معظمهم، يكتفون بالانتقاد، من دون أن يطرحوا بديلاً أو سبيلاً سوى السبيل المطروح أمامنا. وخير ما يشرح الفكرة مَثل سوري دارج، يقول: “من لا يحضر ولادة عنزته، تخلّف له جروا”.
هل ثمة قوى سورية ديمقراطية علمانية حقيقية؟ نعم، لكنها مشتّتة وخَمول وشخصانية. نحن ناشطون جداً في القول ولنا صوت عال، ولكنه فارغ من أي محتوى، لأنه لا يستند إلى بشر حقيقيين، إلى سوريين يؤمنون بذلك ويناضلون في سبيل تحقيقه. فهل من العدل أن نقول إنه لا يوجد بالفعل سوريون يؤمنون بالديمقراطية والعلمانية؟
أحب أن أجيب عن السؤال بلا. فبين السوريين بالفعل شرائح عريضة تبتغي حكماً ديمقراطياً مدنياً، لأن في ذلك إحقاقاً للحق وضماناً لأنفسهم وحماية لمجتمعاتهم واحتراماً لتاريخ سوريٍّ عريق، يعود إلى ما قبل انقلاب البعث وحكم آل الأسد، ومتأصّلة في دساتير 1920 و1930 و1950، التي تحدّد جميعها ديانة رأس الدولة، من دون أن تحدّد ديانة الدولة نفسها، وتعتمد سيادة الشعب عبر مجالسه المنتخبة التي تسنّ القوانين والقرارات الملزمة.
وببعض التفصيل الذي لا بدّ من أن يصطبغ ببعض الطائفيّة، فإنني أعتقد أن جزءاً كبيراً من سنّة المدن وحوران يضافون إلى معظم المسيحيين والعلويين والدروز والإسماعيليين والكرد سيرغبون في نظام كهذا، يحمي حرياتهم وحقوقهم ويحميهم مما اسماه ألكسيس دي توكفيل “طغيان الغالبية” واعتبره واحداً من أخطر التهديدات التي تواجه الأنظمة الديمقراطية.
لكن، كيف بإمكان هذه النسبة الكبيرة من السوريين أن تشكّل رأياً عاماً ضاغطاً في غياب قوى سياسية ديمقراطية حقيقية ومؤثرة تمثّلهم وتقودهم وتتحدّث باسمهم؟
سيتعين على الشرائح الديمقراطية المدنية والعلمانية في سوريا، أن تعمل من دون تمثيل، ولعلّها تستهدي بهدي الفيلسوف والعالم السياسي الإيراني آصف بيات الذي تحدث عن هذه الحالة.
في كتابه ” الحياة كسياسة: كيف يغيّر الناس العاديون الشرق الأوسط”، يقدم آصف بيات منظوراً رائداً للتغيير الاجتماعي والسياسي في المنطقة. وخلافاً للتحليلات التقليدية التي تركز على الحركات المنظمة أو الثورات أو سياسات النخبة، يحوّل بيات العدسة إلى فاعلية الناس العاديين الذين يعيدون تشكيل مجتمعاتهم من خلال الممارسات اليومية. ويتحدى مفهومه المركزي “اللاحركة” Nonmovement كنقيض للحركيات السياسية Political movements المفاهيم التقليدية للنشاط السياسي، مقدماً رؤية دقيقة لكيفية حدوث التغيير في السياقات الاستبدادية والمقيّدة.
مفهوم اللاحركة
يعرّف بيات “اللاحركة” بأنها الأفعال الجماعية للأفراد الذين لا يُعرّفون بالضرورة كجزء من حركة منظمة، لكن أفعالهم المتكررة والمستمرة تؤدي إلى تحوّلات اجتماعية كبيرة. على عكس الحركات الرسمية ذات القيادة المنظمة والبيانات والمطالب الواضحة، تنشأ الحركات غير الحركية بشكل عضوي مع خوض الناس لنضالاتهم اليومية. هذه التحركات المتفرّقة والمترابطة في الوقت نفسه تغيّر تدريجياً المعايير الاجتماعية وتغير المساحات الحضرية وتتحدى السلطة.ويرى بيات أن الحركات غير الحركية فعالة بشكل خاص في السياقات التي يُقمع فيها النشاطُ العلني. فهي تعمل من خلال ما يسميه “التعدي الهادئ للعاديين،” وهي عملية يطالب فيها الأفراد المهمشون بالحقوق والمساحة والموارد من دون مواجهة الدولة مباشرة. فالباعة المتجولون الذين يحتلون الأماكن العامة، والنساء اللاتي يتحدين قواعد اللباس التقييدية من خلال التحدي الخفي، والشباب العاطلون عن العمل الذين يستعيدون المساحات الحضرية كلها أمثلة على ديناميكيات اللاحركة.
يطبّق بيات نظريته على مجموعات اجتماعية مختلفة، ويوضح كيف تؤدي أفعالها التي تبدو غير سياسية إلى تحولات مجتمعية عميقة. وهو يدرس مواضيع من مثل كيف يعيد الباعة المتجوّلون والمستوطنون والعاطلون عن العمل تشكيل الحياة الحضرية من خلال الاستقرار والعمل في الأماكن بشكل غير رسمي رغم القيود الحكومية.
ويركز بيات على النساء في الشرق الأوسط، ويرى فيهن قوة للتغيير المجتمعي، من خلال نضالهن الذكي ضد المعايير الأبوية من خلال المقاومة اليومية بدلاً من الحركات النسوية التقليدية. وهو يعطي مكانة خاصة للنشاط الشبابي ويشرح كيف ينشئ الشباب في الأنظمة الاستبدادية مساحات من الحرية والتعبير عن الذات، غالباً من خلال وسائل ثقافية مثل الموسيقى والأزياء والشبكات الرقمية. وتسلط مقاربة بيات الضوء على فاعلية المحرومين من الحقوق، وتصوّرهم ليس كضحايا سلبيين، بل كفاعلين رئيسيين في التغيير يعملون ضمن قيود مجتمعاتهم.
جوهر القضية بالنسبة الى بيات هو انتقاده الميل إلى تطبيق الأطر التقليدية للثورة والنشاط المنظم على الشرق الأوسط، إذ يجادل أن التغيير في المنطقة غالباً ما يتبع مسارات مختلفة. وهو يرى أن الحركات غير الحركية تتحدى الفكرة القائلة بأن العمل السياسي الهادف يجب أن يكون دائماً صريحاً أو تصادمياً أو منظماً. بدلاً من ذلك، تُظهر هذه الحركات كيف يمكن للتحركات التدريجية واللامركزية أن تقوّض السيطرة السلطوية مع مرور الوقت.
في غياب حركة ديمقراطية مدنية منظمة في سوريا، لا يبقى أمامنا كسوريين سوى حراك “لا حركي،” غير مؤطر وغير منظم، تقوده قطاعات عريضة من سكان المدن والمجموعات الدينية والعرقية التي لا يمكنها التعايش مع أي نظام من لون واحد.
----------
درج
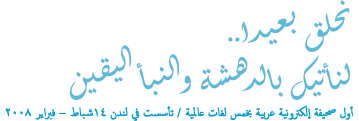

 الصفحات
الصفحات سياسة
سياسة




















