هذا التحول لا يُفهم من منظور التكلفة وحدها، بل من منطق إعادة تعريف المصالح الأميركية نفسها، بعد أن بات النظام الذي رعته واشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أقل فاعلية، وأكثر كلفة، وأشد فائدة لخصومها من حلفائها.
إعادة تموضع لا انسحاب
ما يبدو للوهلة الأولى كفقدان للنفوذ أو تراجع في الحضور، هو في حقيقته انتقال استراتيجي نحو إدارة العالم عن بُعد. انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، التباطؤ في دعم أوكرانيا، تقليص التمويل للمؤسسات الأممية، وتفكك الدور الأميركي في ملفات الشرق الأوسط، لا تمثل فقدانًا للقدرة، بل تكيّفًا مع عالم غير قابل للإدارة المباشرة، وأكثر نفعًا حين يكون في حالة اضطراب.
مراكز تفكير أميركية بارزة، مثل مؤسسة راند، تشير صراحة إلى أن الولايات المتحدة تعيد تعريف مفهوم الهيمنة. لم تعد السيطرة على النظام الدولي أولوية، بل ضمان ألا تسيطر عليه قوى منافسة. من هذا المنظور، يصبح التفكك الدولي مدخلًا لإعادة ترتيب العالم وفقًا لتوازنات أكثر قابلية للإدارة، وأقل اعتمادًا على القوة الصلبة.
الجغرافيا كميزة استراتيجية
يمنح الموقع الجغرافي الأميركي أفضلية يصعب مقارنتها: دولتان جارتان ضعيفتان، ومحيطان يفصلانها عن مراكز التوتر الكبرى. هذه العزلة الطبيعية باتت تُستخدم كأداة استراتيجية. فبينما تنشغل القوى الكبرى بمحاور الاحتكاك المباشر، يمكن للولايات المتحدة أن تعيد تموضعها داخليًا، وتحصّن اقتصادها، وتبني نموذجًا أقل عرضة للانكشاف، وأكثر قدرة على التحكم بالتداعيات عن بُعد.
التوجه نحو الحماية التجارية، وإعادة توطين الصناعات، والتحول إلى اقتصاد أكثر مرونة في مواجهة اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، كلها مؤشرات على تصور استراتيجي لما بعد العولمة. وبحسب صانع السياسات الأميركي، لم تعد الكفاءة الاقتصادية أولوية، بل الصلابة الذاتية في مواجهة التفكك العالمي المحتمل.
اضطراب محسوب
الولايات المتحدة لا تسعى إلى إشعال الفوضى، لكنها لم تعد تعمل على منعها. في شرق أوروبا، يطول أمد الحرب بين روسيا وأوكرانيا دون تدخل حاسم. في شرق آسيا، تُرفع وتيرة التوتر مع الصين، لكن دون مواجهة مباشرة. في الشرق الأوسط، تتراجع الإدارة الأميركية عن الالتزام التقليدي بأمن الإقليم، دون أن تقدم بدائل واضحة.
هذه الفوضى غير المدارة تُضعف خصومًا محتملين، وتزيد من اعتماد الحلفاء على الولايات المتحدة، وتتيح لها التدخل الانتقائي عند الحاجة. وهي سياسة تستند إلى فكرة أن الانهيارات الموضعية، ما دامت لا تتجاوز حدودًا معينة، قد تكون أكثر فائدة من محاولة حفظ استقرار دولي لم يعد ممكنًا أو مرغوبًا فيه.
انهيار النظام الدولي القديم
المؤسسات التي أسستها واشنطن نفسها لم تعد قادرة على أداء وظائفها. البنك الدولي، صندوق النقد، الأمم المتحدة، وحتى حلف شمال الأطلسي، تشهد تآكلًا تدريجيًا في قدراتها ومشروعيتها. هذا الانهيار لا يواجه بحلول، بل يُترك ليأخذ مجراه، ضمن تصور يراه البعض في واشنطن خطوة ضرورية لإعادة صياغة النظام العالمي على قواعد جديدة، أكثر مرونة، وأقل التزامًا بالقيم الليبرالية التي ميزت المرحلة السابقة.
في المقابل، تُمنح الصين وروسيا وإيران وتركيا حرية التحرك ضمن مساحات محدودة، تُبقيها منشغلة ومتورطة، لكنها لا تمنحها نفوذًا فعليًا طويل الأمد. ما ينتج عن ذلك ليس نظامًا جديدًا، بل حالة دائمة من اللايقين، يمكن للولايات المتحدة أن تتحرك فيها بمرونة أعلى من الجميع.
الشرق الأوسط كنموذج
المنطقة التي طالما ارتبط استقرارها بالإدارة الأميركية، لم تعد ضمن أولوياتها المباشرة. تراجع الحضور الأميركي في سوريا والعراق، غياب خطة واضحة لإعادة الإعمار في سوريا، وانكماش التمويل للمساعدات الإنسانية، كلها مؤشرات على تخلٍ منهجي لا عن النفوذ، بل عن مسؤولية الرعاية؛ نفوذ بلا حماية.
تمثل سوريا حالة نموذجية في المشهد العالمي المتحوّل؛ دولة أنهكها صراع داخلي طويل، تفتقر إلى القدرة على إعادة التموضع السياسي أو الاقتصادي، وتُترك في فراغ تتقاطع فيه مشاريع إقليمية متضاربة، دون وجود فاعل دولي لديه الاستعداد لتحمّل كلفة إعادة البناء أو فرض تسوية شاملة. مؤسسات الدولة متآكلة، النسيج الاجتماعي منهك، والبيئة القانونية والاقتصادية طاردة، ما يجعل الاستثمار أو التدخل طويل الأمد مخاطرة غير محسوبة لأي طرف خارجي.
ورغم ذلك، تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري فعّال في شرق سوريا، ليس في إطار مشروع استقرار داخلي، بل كجزء من استراتيجية احتواء جيوسياسية تمتد من شرق المتوسط إلى قلب آسيا إلى عمق آسيا الوسطى، على تخوم النفوذ الصيني. هذا الحضور يرتبط بخطوط التماس مع قوى إقليمية ودولية تشمل إيران وروسيا، لكنه يتسع ليشمل تركيا — التي باتت تمارس سياسة خارجية مستقلة على نحو متزايد — والصين، بوصفها الفاعل الصاعد الذي يسعى إلى تثبيت موطئ قدم في الإقليم من بوابات اقتصادية وأمنية.
بمعنى آخر، الوجود الأميركي في سوريا وظيفي لا سيادي، مرتبط بحسابات كبرى تتجاوز الداخل السوري نفسه، وتُفهم في سياق جغرافي أوسع يُعاد تشكيله على وقع التوترات العالمية. وفي غياب مشروع دولي لإعادة البناء أو حتى إدارة مستقرة للفوضى، تُترك سوريا كساحة معلّقة، خارج النظام الذي انهار، وخارج النظام الذي لم يولد بعد.
ما بعد الاستقرار
القرن العشرون كان قرنًا أميركيًا بامتياز، لكنه قام على افتراض أن النظام الدولي قابل للتنظيم والضبط. اليوم، يبدو أن واشنطن تسعى إلى قرن جديد، لا تحكمه مؤسسات ولا توازنه تحالفات، بل تديره القوة من مسافة آمنة، وتُقيّمه وفق مدى انعكاسه على الداخل الأميركي. إنه ليس انسحابًا، ولا انعزالًا. بل مقامرة لتصور عالم جديد، تكون فيه الولايات المتحدة أقل التزامًا، وأكثر تحكمًا، في نظام عالمي ينهار ببطء، لكنه لا يسقط خارج حساباتها.
وفي ظل هذا التحول، قد لا يكون السؤال كيف ستحكم أميركا العالم، بل: هل يتكيف العالم بطريقة خارج هذه الحسابات؟
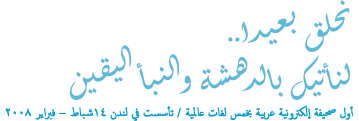

 الصفحات
الصفحات سياسة
سياسة




















