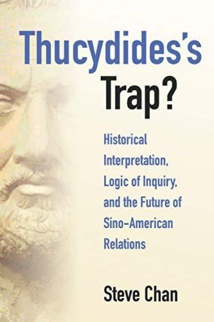هل تعمل الولايات المتحدة للحفاظ على الوضع القائم في النظام الدولي أم تسعى تعديله ؟
للحصول على هذا التقرير بهيئة ملف PDF
المحاور
تمهيد
1. الرضى وعدم الرضى عن النظام الدولي
2. عن أيّ نظامٍ دولي نتحدّث؟
3. النظام الدولي والحروب الهيكلية
4. ماذا عن النظام الدولي الليبرالي؟
5. النزعتيْن الأحادية و التعديلية لواشنطن
6. ماذا بخصوص السلوك الصيني السيّء؟
خاتمة
ترتكزُ هذه الدراسة على إحدى المحاور الأساسية لكتابه “فخّ ثيوسيديدس؟ التأويل التاريخي، منطق التحقيق ومستقبل العلاقات الصينية الأمريكية” الصادر عام 2020. يستند التصوّر السائد عن قوى الوضع القائم والقوى التعديلية وكذا الحروب/التوتّرات “الحتميّة أو المحتملة جدًّا” الناجمة عن التنافس بينها على كلٍّ من مقاربة “انتقال القوة” التقليدية (Power Transition Theory) للباحثيْن أورغانسكي وكوغلر (Abramo Fimo Kenneth Organski and Jacek Kugler) ومقاربة “فخّ ثيوسيديدس” الحديثة Thucydides’s Trap)) لـ غراهم أليسون (Graham T. Allision).
يلاحظ تشان بأنّ نظرية انتقال القوة تُرجع حدوث خطر الحرب إلى متغيّرين: أولاً، تحوّل القوة الذّي يُقرّب فجوة الامكانيات بين دولةٍ صاعدةٍ ودولةِ وضعٍ قائم. ثانيًا، مُحفّز القوة التعديلية أو بالأحرى الأجندة التّي تتبنّاها الدولة الصاعدة، فكلا المتغيرين يُعتبران شرطيْن ضروريّيْن لحدوث الحرب. إلاّ أنّ تشان يُحاجج بأنّ اهتمام الباحثين قد انصّب أساسًا على تحليل كيفيّة تأثير انتقال القوة، في حين تمّ القيام بعملٍ منهجيٍ ضئيلٍ نسبيًا لتحديد ما إذا كانت الدولة تعديليةً أم لا، وبالتالي فإنّ الكثير من الأدبيات القائمة لا تتناول الشرط الذّي تضعه نظرية انتقال القوة القائل بأنّ “خطر الحرب الهيكلية يعتمد على تأثير مشتركٍ لهذين العاملين.”
يُقدّم تشان عرضًا موجزًا لجوهر نظرية انتقال القوة والتّي تحصر –في نظره- فواعلها في وجود قوتّيْن متنافستيْن في نظامٍ “هيراركي/تراتبي” (وليس آناركي/فوضوي). يرى دعاة هذه النظرية بأنّ الحربيْن العالميتيْن كانتا بسبب تحدّي ألمانيا لبريطانيا والنظام الذّي تزعّمته لندن، وبالتالي سعي ألمانيا لإزاحة بريطانيا عن الصدارة العالمية والحلول محلّها. لكن من المهّم الالتفات هنا إلى تجاهل هؤلاء لوجود الولايات المتحدة أصلاً ضمن هذا المسرح، وللعلم فإنّ ألمانيا لم تتجاوز أبدًا الولايات المتحدة وقد صارت الأخيرة البلد الأكثر قوةً بالفعل في أواخر سنوات الــ 1800م وفقًا لمعيار الحجم الاقتصادي (الذّي يُعدُّ المؤشّر الأفضل في نظرية انتقال القوة).
من المفارقات الساخرة أنّه في الحالة الواحدة والوحيدة منذ سنة 1815 لانتقال القوة بين قوتين رائدتين في العالم (أي عندما حلّت الولايات المتحدة محلّ بريطانيا كقوةٍ مهيمنةٍ في العالم) كانت نتيجة الانتقال سلميةً وانتقلت القوة من دون وقوع حربٍ كبرى (رغم وجود توتّراتٍ عديدة)، وهذا ما يتناقض مع توقّعات نظرية انتقال القوة.
في نقده للنظرية، يحاجج تشان بأنّه عادةً ما يُصوّر مؤيّدوها الولايات المتحدة على أنّها قوة وضعٍ قائم، وبالتالي يستثنونها من الاتجاه العام للقوى الصاعدة بأن تكون دولةً تعديلية، لذلك يرى بأنّ طريقة المعالجة هذه تُعيدنا مُجدّدًا إلى التساؤل الجاد عن ماهية المؤشّرات المناسبة والصالحة التّي يمكن أن تؤشّر إلى وجود نزعةٍ تعديليةٍ ما لأيّ بلد. هكذا يُقدّم تشان في هذه الدراسة نقدًا صارمًا لنظرية انتقال القوة وما ارتكز عليها لاحقًا من مقارباتٍ نظريةٍ كمقاربة “فخّ ثيوسيديدس”، مُقترحًا إعادة النظر في المعايير التّي تجعل الباحثين يُميّزون القوى التعديلية عن قوى الوضع القائم، لاسيما أثناء معالجتهم لطبيعة العلاقة التنافسية الحاليّة بين الولايات المتحدّة والصين.
الرضى وعدم الرضى عن النظام الدولي
يُناقش القسم الأول من الدراسة مسألة القوى الراضية و الساخطة في النظام الدولي، مُقدّمًا انتقاداتٍ جوهريةٍ لنظرية انتقال القوة التّي أرست لهذا التصنيف ومعاييره وصارت مرتكزًا للعديد من الدراسات اللاحقة إلى اليوم. تحصر نظرية انتقال القوة -كما أشرنا سابقًا- فواعل النظام الدولي في قوتّين اثنتين تتنافسان في نظامٍ هيراركيٍّ (وليس آنركي)، فقد ركّزت مثلاً على بريطانيا كقوة وضعٍ قائمٍ وألمانيا كقوةٍ تعديليةٍ أثناء الحرب العالمية الثانية، بينما تجاهلت وجود الولايات المتحدّة الصاعدة آنذاك وطريقة الانتقال السلمي للقوة بينها وبين بريطانيا من دون حدوث حربٍ بينهما. يُحاجج تشان بأنّ العديد من انتقالات القوة حدثت على نحوٍ سلمي، ففي العقود الأخيرة تجاوزت الصين كلاًّ من بريطانيا وألمانيا واليابان وروسيا، كما تجاوزت اليابان بريطانيا وألمانيا وروسيا، لكن لم تحدث حربٌ بينها في خضّم هذه التطوّرات.
تفترض نظرية انتقال القوة أيضًا بأنّ القوة الراسخة المُهيمنة تكون قوةً راضيةً عن النظام الدولي لأنّها الطرف الذّي أنشأته وهي أكبر مستفيدٍ من مزاياه، لذلك تسعى للمحافظة عليه. تُعرِّف هذه النظرية القوة المهيمنة بأنّها قوةٌ راضيةٌ وبالتالي فهي الطرف المدافع عن الوضع القائم. إنّها تُنشؤ التسلسل الهرمي العالمي أو الإقليمي الذّي تحصل منه على فوائدٍ كبيرةٍ وتُحافظ عليه. في مقابل ذلك، فإنّ توزيع المنافع في ظلّ النظام القائم يكون في غير صالح القوى الصاعدة التّي لم يكن لها صوتٌ في تحديد هذا النظام، ومن المفترض بأنّها ستكون قوى غير راضية ولها حوافزٌ لزواله، ومع اكتساب هذه الدول مزيدًا من القوة فمن المفترض أن تجعل قدراتها المتزايدة تهديدًا أكبر للنظام القائم.
فلأنّ هذا الرأي السائد يُحاجج بأنّ الدولة الحاكمة (المُهيمنة) لا يمكن أن تكون غير راضيةٍ عن النظام القائم، فإنّه يفترض تبعًا لذلك عدم وجود أيّ احتمالٍ بأن تكون هذه الدولة قوةً تعديلية. كما يفترض بأنّ الدولة المهيمنة ملتزمةٌ بالنظام الدولي لأنّها المستفيد الأكبر من المحافظة عليه. إلاّ أنّ هذا الطرح لا يأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت القوة الحاكمة (المهيمنة) في حالة تدهورٍ نسبي، فقد يكون لها حصّةٌ أقلّ وبالتالي حافزٌ أقلّ للحفاظ على النظام القائم. قد تصبح الدولة أكثر استياءً ويكون لها دافعٌ لقلب النظام الدولي بهدف عكس مسار انحدارها. في الوقت نفسه فإنّ الخطاب التقليدي لا يأخذ بعين الاعتبار إمكانية حصول قوةٍ صاعدة -أثناء صعودها في التسلسل الهرمي بين الدول- على حصّةٍ أكبر في النظام القائم. فلماذا تطيح هذه القوة بالنظام الذّي مكنّها من الصعود؟ على الرغم من أنّ الدولة الصاعدة لديها الآن قدرةٌ أكبر على تحدّي هذا النظام، ينبغي أن يكون لها حافزٌ أقلّ للقيام بذلك. في المقابل، يجب أن يكون لدى الدولة المهيمنة المنحدرة القدرة الأكبر على مراجعة النظام.
علاوةً على ذلك يرى تشان بأنّ هناك تقاربٌ وانجذابٌ بين تصوير مُهيمنٍ ما على أنّه مُدافعٌ عن النظام الدولي وبين نظرية الاستقرار بالهيمنة التّي صاغها روبرت غيلبين وكتب عنها قبله تشارلز كيندلبرغ . )تُجادل هذه النظرية بأنّ الاستقرار الدولي يتطلّب وجود بلدٍ قويٍّ يتمتّع بكلٍّ من القدرة والحافز الضروريّين لتجاوز مشكلة الراكب/المستفيد المجانّي وتوفير السلع العامّة للعالم، إذْ سيكون العالم أكثر سلامًا وازدهارًا عندما تكون هناك قوةٌ راجحةٌ مهيمنةٌ فيه. على العكس من ذلك، سيتعرّض توفير السلع العامّة للخطر عندما ينحدر هذا الطرف المهيمن. أمّا مُنظّرو انتقال القوة فلا يُفكّرون في احتمال أن تكون القوة المهيمنة أقلّ ميلاً لتحمّل عبء توفير السلع العامّة مع تدهور قوتّها النسبية، فهُم يفترضون بأنّها ستبقى ثابتةً في دعهما للنظام الدولي حتّى في حالة معاناتها من التدهور المطلق أو النسبي. كما أنّهم يتغاضون عن إمكانية أن يكون النظام الدولي مدعومًا من أنظمةٍ متعدّدةِ الأطراف مثل نظام وفاق أوروبا الذّي عُرف سابقًا في التاريخ، أو حالة النظام الدولي الحالي الذّي طُلب فيه من الصين بأن تكون “صاحبة مصلحةٍ مسؤولةً” وأن تزيد مساهماتها في توفير المنافع العامّة الدولية.
فيما يرتبط بالصين، يؤكّد تشان بأنّنا من أجل فهم ماذا تريد بيجين وتفسير سلوكاتها، فإنّنا في حاجة إلى مقارنة سلوك الدولة بماضيها والسلوكات الخاصّة بأقرانها بدلاً من التعامل معها بمعزل عن غيرها.
عن أيّ نظامٍ دولي نتحدّث؟
يُراجع القسم الثاني بعضًا من “المسلّمات البديهية” المتعلّقة بمدلول النظام الدولي، ويرى بأنّ هناك خلطًا يقع فيه الباحثين بين مفهوم النظام الدولي ومسألة توزيع القوة بين الدول. عادةً ما يستبعد الباحثون (تحت تأثير نظرية انتقال القوة) احتمال أن يكون للدول الراسخة (المهيمنة) دافعٌ لتغيير التوزيع الحالي للقوة داخل النظام بهدف تعزيز قوتّها، ويفترضون خطأً بأنّ هذه الدول ستستقر على ما لديها وتدافع عنه ولن تطلب المزيد. كما يفترضون بأنّ محاولة دولةٍ ما تحسين قدراتها (وبالتالي تغيير توزيع القوة الحالي لصالحها) يجعلها بالضرورة قوةً تعديليةً متحدّيةً للنظام الدولي، مُشيرين في الوقت الحالي إلى الصين كمثالٍ عن ذلك، حيث وصف البنتاغون مؤخّرًا الصين بأنّها قوةٌ تعديليةٌ تسعى إلى “إعادة ترتيب المنطقة لصالحها من خلال الاستفادة من التحديث العسكري وتسخير عمليات النفوذ والاقتصاد المفترس لأجل إكراه الأمم الأخرى.” ينتقد الكاتب هذه المنطلقات الافتراضية ويرى بأنّه يمكن لأيّ دولةٍ أن تسعى مثلاً إلى تحسين قوتّها من دون تحدّي النظام الدولي (مثال الولايات المتحدة وبريطانيا سابقًا والذّي يستخدمه منظرّو انتقال القوة)، فمن المفترض أنّ جميع الدول ترغب في الحصول على مزيدٍ من القوة وليس أقلّ، هذا ما فعلته الولايات المتحدّة نفسها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، أي حتّى بعد ضمان صدارتها العالمية وغياب أيّ منافس آخر لها، فقد سعت إلى مواصلة تحسين وضعها الدولي مثلما تعكسه كثيرٌ من المؤشّرات كزيادة الميزانية العسكرية، توسيع حلف الناتو وغيرها.
علاوةً على ذلك، يشير الكاتب إلى التحيّز الذّي يُميّز أدبيات انتقال القوة والتّي اعتَبرت الولايات المتحدّة تاريخيًا قوة وضعٍ قائمٍ بالرغم من سلوكها التعديلي أثناء صعودها حينما سعت لازاحة النفوذ الأوروبي عن النصف الغربي للعالم بموجب مبدأ مونرو، وأصرّت على حقّها للتدخّل منفردةً في شؤون الدول الأخرى في المنطقة، وهو ما ينطبق أيضًا على بعض القوى الإمبريالية الاستعمارية السابقة في أوروبا التّي انخرطت في التوسّع، لذا فمن المهمّ في نظر تشان التمييز بين هذا السلوك التوسّعي بدافع الرغبة في تحصيل المزيد من القوة والموارد والأراضي، وبين رغبة الدولة أو نيّتها في قلب النظام القائم. يلفت هينري كيسنجر الانتباه لهذا التمييز واصفًا السياسة العالمية بأنّها “مجموعةٌ من القواعد المقبولة عمومًا والتّي تُحدّد حدود الفعل المسموح به وتوازن القوى الذّي يفرض قيودًا حيث تتعطّل القواعد، ممّا يمنع وحدةً سياسيةً واحدةً من إخضاع الآخرين جميعًا”. هكذا، يشير النظام الدولي إلى مجموعةٍ من القواعد المشتركة على نطاقٍ واسعٍ والتّي تحكم العلاقات بين الدول، تُشكّل هذه القواعد التوافقية أو المعايير أساس المجتمع الدولي باعتباره متميّزًا عن النظام المشترك بين الدول والقائم على سياسة القوة وديناميكيتها. تُميّز المدرسة الانجليزية في العلاقات الدولية بين المؤسّسات الأساسية للنظام وبين مؤسّساته الثانوية، فقد كانت سيادة الدول وسلامة/وحدة أراضيها بمثابة المؤسّسات الأساسية للنظام الدولي منذ معاهدة وستفاليا عام 1648، ثمّ تمّ إنشاء مؤسّساته الثانوية بناءً على هذه القواعد والمؤسّسات الأساسية كالمنظمات الحكومية والاتفاقيات متعدّدة الأطراف (هيئة الأمم المتحدّة وقانون البحار واتفاقيات جنيف وغيرها).
على الرغم من أهميّة هذا التمييز من الناحية المفاهيمية إلاّ أنّ النظام الدولي وتوزيع القوة بين الدول مسألتان مرتبطان عمليًّا، فعادةً ما يتّم إدخال معاييرٍ وقواعدٍ ومؤسّساتٍ جديدةٍ بعد الحروب المدمرّة حينما يكون قائد الائتلاف الفائز في موضعٍ قويّ بشكلٍ خاصّ. صحيحٌ بأنّ الدولة المهيمنة تلعب دورًا حاسمًا في إنشاء النظام، إلاّ أنّ القوة وحدها لا تكفِ، إذ أنّ موافقة الدول الأخرى وتعاونها أمران ضروريان أيضًا لاستمراره.
إضافةً إلى ما سبق، يرى تشان بأنّ النزعة التعديلية (التّي تعني بمعناها الحرفي الدقيق محاولة تغيير القواعد الحاليّة للنظام الدولي) ليست سِمةً حصريةً للقوى الصاعدة فحسب، مُشيرًا إلى الولايات المتحدّة خصوصًا (التّي يتّم اعتبارها قوة وضعٍ قائمٍ مهيمنة) حينما سعت مرارًا إلى تعزيز عقائدٍ ومبادئٍ جديدةٍ في النظام الدولي كــ “مبدأ مسؤولية الحماية” في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومبدأ “تغيير النظام” للإطاحة بحكوماتٍ أجنبية مرفوضة، و مبدأ “الحرب الوقائية” باسم الدفاع عن النفس. كما يُمكن للقوة غير الصاعدة أيضًا أن تتصرّف بشكلٍ مشابه، على سبيل المثال سعت البلدان النامية في منتصف سبعينيات القرن العشرين لإنشاء “نظامٍ اقتصاديٍ دوليٍ جديد” وطالبت بتفكيك المؤسّسات العنصرية. لذلك، فجميع الدول بغضّ النظر عن قوتّها تميل لأن تكون دولاً تعديلية انتقائية، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، ولا ينبغي استخدام مصطلح النزعة التعديلية ككلمةٍ ازدرائية للإشارة إلى السياسات التّي لا يُوافق عليها أحد المراقبين.
النظام الدولي والحروب الهيكلية
تُفسّر سرديات انتقال القوة الحروب الهيكلية على أنّها حروبٌ نابعةٌ من المنافسة بين أقوى دولتيْن في العالم لتحديد طبيعة النظام الدولي. يرى تشان بأنّ هناك العديد من المشاكل مع هذا الرأي.أولاًّ، يحمل هذا الرأي تشويهًا جسيمًا حينما يُوحي بأنّ أيّ بلدٍ قويٍّ يمكنه ببساطة لوحده أن يفرض رؤيته للنظام الدولي على الآخرين. في الحقيقة، لا يتطلّب النظام قيادةً من الأقوياء فحسب، ولكن موافقةً من الدول الأقلّ قوةً أيضًا. على الرغم من أنّ الدولة المهيمنة يمكن أن تلعب دورًا رائدًا في تعزيز قواعدٍ معيّنةٍ وفرض أخرى، فإنّ الشرعية أكثر أهميةً من الإكراه في إقناع الآخرين بقبول هذه القواعد. تُشير الشرعية إلى الإيمان المشترك واسع النطاق بأنّ القواعد والمعايير صحيحة وعادلة، وهي تستند لمنطق الملاءمة أكثر من منطق العواقب.
ثانيًا، تمنح الروايات السائدة أولويّةً للدور الذّي تلعبه الحروب الهيكلية في تشكيل طبيعة النظام الدولي. لذلك، يمنح الباحثون اهتمامًا قليلاً للطرق البديلة لحدوث ذلك، بما فيها الإصلاح المؤسّساتي السلمي لتشكيل النظام الدولي. يُشير تشان مثلاً للاصلاح الذّي تمّ بموجبه تعديل حصص التصويت في صندوق النقد الدولي ليعكس بشكلٍ أدّق الأهميّة المتزايدة للاقتصاديات النامية كمثالٍ من بين عديد الأمثلة عن نمط هذا الاصلاح السلمي الذّي يطال النظام الدولي من دون حروبٍ هيكلية.
إضافةً إلى ذلك يحاول تشان التمييز بين نمطين متباينين من الأنظمة الدولية، وهي الأنظمة الدولية التقيّيدية والأنظمة الدولية المتساهلة( . يُوضّح تشارلز كيجلي وغريغوري ريموند بأنّ: “الأنظمة التقيّيدية تحتوي على معاييرٍ دوليةٍ تُحدّد خطوط ترسيم الحدود، وتُدعّم حُرمة الأراضي المحايدة، وتُدّعم مبدأ عدم التدخّل، وكلّما قلّ الدعم المُقدّم لهذه الأنماط من قواعد اللعب، كلّما كان النظام المعياري أكثر تساهلاً وحريّةً في الاختيار”. يشتمل النظام التقيّيدي أيضًا على القواعد التّي تحدّ من استخدام الدول للقوة وتعترف بشرعية النخب الحاكمة وتحترم وحدة أراضي الدول الأخرى وتُشدّد على قدسيّة الاتفاقيات الدولية وتعترف بمجال نفوذ كلّ قوةٍ عظمى. حينما يكون هناك إجماعٌ واسعُ النطاق حول هذه المعايير والالتزام بها تكون العلاقات الدولية أكثر استقرارًا وسلمًا، بمعنى آخر، حينما تلتزم القوى الكبرى برؤيةٍ مُقيّدةٍ للنظام الدولي يُصبح العالم أكثر سلامًا. على العكس من ذلك، يتميّز النظام الدولي المتساهل بكثرة الاضطرابات والصراعات. لقد أيّدت الدول الغربية -بقيادة الولايات المتحدة- مبادئ الحرب الوقائية وتغيير النظام في الخارج (في العراق وليبيا وسوريا وفنزويلا..) والتّي تتحدّى المبادئ الهامّة للنظام الدولي التقيّيدي، كما وسّعت نفوذها بتوسعة حلف شمال الأطلسي باتّجاه “الخارج القريب” لروسيا رغم اعتراف الدول الغربية هذه في السابق -ضمنيًا على الأقل- بوجود مجال نفوذٍ سوفياتيٍ في أوروبا الشرقية. كما دعمت الدول الغربية الحركات الانفصالية التّي حطّمت يوغسلافيا السابقة (ولم تدعم انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا)، إضافةً إلى دعمها للعديد من “الثورات المُلونّة” للاطاحة بالحكومات القائمة. تُشير الأحداث الأخيرة التّي يعرفها العالم إلى أنّنا دخلنا فترة نظامٍ دوليٍ أكثر تساهلاً، فهي ليست مجرّد حقبة تنافسٍ أكبر على المؤسّسات الثانوية للنظام الدولي، ولكنّها حقبةٌ تنطوي أيضًا على مزيدٍ من الاعتداءات المباشرة على مبادئه ومؤسّساته الأساسية كالسيادة وعدم التدخّل.
ماذا عن النظام الدولي الليبرالي؟
وُصف النظام الليبرالي بعد 1945 بأنّه ميثاقٌ دستوريٌ نظمّته واشنطن، وبأنّه ذلك النظام “المفتوح والمتكامل والقائم على القواعد”. كانت عضويتّه الأساسية تتكوّن من دول منطقة شمال الأطلسي التّي تميّزت بالديمقراطية والسوق الحرّة. كان حلف الناتو و نظام بريتون وودز المؤسّستيْن الثانويّتيْن الرئيسيتيْن لهذا النظام. لكن الأحداث الأخيرة دفعت البعض إلى التساؤل عمّا إذا كان هذا النظام الليبرالي سيستمر وما إذا كانت الولايات المتحدة بصفتها القوة المهيمنة الحالية قد أصبحت قوةً تعديلية.
بدايةً، يقدّم تشان شرحًا لفكرة إيمانويل كانط عن السلام الأبدي وكيف صارت أساسًا لفكرة التكاملات الليبرالية ونظريّاتها والتّي انتشرت نماذجها وأمثلتها وشاعت خاصّةً بعد الحرب الباردة واستلام الأنظمة الاستبدادية لإرساء الديمقراطية وانضمام دولٍ عديدةٍ منها إلى منظماتٍ دوليةٍ مختلفة، “حتّى صار هناك شعورٌ بالبهجة بأنّ الديمقراطية والرأسمالية قد انتصرت على جميع المنافسين الايديولوجيّين”. يرى تشان بأنّ هذا التفاؤل والثقة بشأن انتشار نظامٍ دوليٍ ليبراليٍ وتعزّزه ليس لهما ما يُبرّره تمامًا. بالرغم من أنّ فكرة السلام الديمقراطي القائلة بأنّ “الديمقراطيات لا تُقاتل بعضها البعض” تحظى بدعمٍ تجريبيٍ عمليٍ كبير، إلاّ أنّ نسختها الأحادية “أيْ القائلة أنّ الديمقراطيات بشكلٍ عامٍ أكثر سلميةً من غيرها” تظلّ موضع شكّ، فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند وإسرائيل (وكلّها ديمقراطيات) تُعتبر من بين البلدان التّي سجّلت أعلى معدّلات التوّرط في الحروب والنزاعات العسكرية بين الدول.
أمّا بالنسبة للاتحاد الأوروبي المُسمّى “بالاتحاد الهادئ” فقد عانى التكامل فيه من نكساتٍ كان أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بالتزامن مع ذلك، عانت عملية الدَمَقْرَطة من نكساتٍ في بلدانٍ كالمجر وبولندا، فضلاً عن صعود النزعة الشعبوية المعادية للمهاجرين والنزعة المعادية للعولمة وكراهية الأجانب وذلك في معاقل الدول الليبرالية ذاتها، من دون أن ننسى تنامي النزعة الحمائية الاقتصادية والنزعة القومية وحتّى الانعزالية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة (المناصرين التقليدّيين للنظام الدولي الليبرالي) حتّى أنّ جوزيف ناي ذكر بأنّ “التهديد المحتمل للنظام الدولي الليبرالي يأتي من السياسات الشعبوية في الداخل بدلاً من التحدّيات القادمة من الخارج”.
لقد كان النظام الدولي الليبرالي مدعومًا بسياسات القوة الصارمة وخاصّةً التأثير الساحق للولايات المتحدة. كان هذا النظام نظامًا محدودًا من حيث النطاق الجغرافي (Bounded Order) ولم يكن دوليًا بالفعل، فقد استثنت مؤسّساته الاقتصادية الدول الشيوعية سابقًا. علاوةً على ذلك فلم يكن البُعد الأمني لهذا النظام ليبراليًا للغاية، حيث تضمّنت التحالفات التّي تقودها الولايات المتحدة حكوماتٍ يمينيةٍ استبدادية، ولم يُقيّد هذا النظام الولايات المتحدة ويكبحها عن ممارسة القوة عندما شعرت بأنّ المصالح المهمّة تتطلّب منها التصرّف من جانبٍ واحدٍ وضدّ المعايير القائمة. أمّا من الناحية الاقتصادية فإنّ الدفع نحو “الانفصال عن العولمة” أو في حالة الولايات المتحدة إلى “الانفصال اقتصاديًا” عن الصين جاء من طرف الغرب، لا من جهة الصين.
النزعتيْن الأحادية و التعديلية لواشنطن
يتتّبع تشان في هذا القسم من الدراسة ما يراه مظاهرًا لنزعةٍ أحاديةٍ وتعديليةٍ أبدَتْها الولايات المتحدة منذ زمنٍ طويل، فلا يرجع ذلك في نظره إلى فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب فحسب، بل يمتّد ذلك إلى زمنٍ بعيدٍ قبله. لقد رفضت الولايات المتحدة التقيّد بالالتزامات الدولية في مناسباتٍ كثيرةٍ كرفضها الانضمام لعصبة الأمم مع نهاية الحرب العالمية الأولى، كما رفضت بعدها الانضمام لمنظمة التجارة الدولية وأطالت مدّة التفاوض حولها وحول بروتوكول كيوتو بشأن الاحتباس الحراري واتفاقية باريس للمناخ ورفضت المحكمة الدولية واتفاقية الأمم المتحدة للبحار (UNCLOS)، كما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سنة 1999 رغم دعم بيل كلينتون لها، وغيرها من الأمثلة.
أمّا في فترة حكم دونالد ترامب فقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المعروف بخطّة العمل الشاملة المشتركة، كما انسحبت من الشراكة عبر الباسفيك ومعاهدة القوات النووية متوسّطة المدى والاتفاق العالمي بشأن الهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومن مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة. أيضًا اعتبر ترامب اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية “أسوأ صفقةٍ تجاريةٍ في التاريخ” وهدّد بالانسحاب منها ما لم يتمكّن من التفاوض على شروطٍ أكثر فائدةٍ لصالح الولايات المتحدة، كما سحب الولايات المتحدة من معاهدة تجارة الأسلحة ومعاهدة الأجواء المفتوحة ومنظمة الصحّة العالمية. علاوةً على ذلك قاطعت واشنطن منظمة العمل الدولية وهدّدت بالانسحاب من الاتحاد البريدي وهي تتأخّر بشكلٍ مزمنٍ في سداد المستحقات الماليّة الخاصّة بها في هيئة الأمم المتحدة. من المعروف أيضًا ازدراء إدارة ترامب للمؤسّسات والاتفاقيات متعدّدة الأطراف وإظهارها عدم الثقة بها، وهي بذلك لم تُظهر سوى نزعةٍ أكثر وضوحًا لرفض المؤسّسات الثانوية للنظام الدولي.
أشار سلوك إدارة ترامب إلى حدوث تراجعٍ عن ركيزتيْن من ركائز فلسفة إيمانويل كانط للسلام الدائم –بل وحتّى الاعتداء عليهما- وهما الكوسموبوليتانية والاتحاد السلمي (Cosmopolitanism and Pacific Union)، كما أنّ الادعاءات التّي أطلقتها إدارته بكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2020 قد تمّ “سرقتها” وما تبع ذلك من فضيحة في مبنى الكابيتول تُهدّد أيضًا الركيزة الثالثة لفلسفة كانط والمتمثّلة في الديمقراطية.
قبل أن يصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، كتب ستيفن وورد (Stephen Ward) وجادل بأنّ ألمانيا واليابان كانتا قوتّين تعديليتين قبل الحرب العالمية الثانية لأنّهما رفضتا المشاركة في المؤتمرات والاتفاقيات الدولية للحدّ من التسلّح أو قاطعتا المنظمات الدولية كعصبة الأمم أو انسحبتا منها وتعهدّتا بمباشرة برنامج تسليحٍ منسّقٍ بشكلٍ مشتركٍ بينهما، وفي هذا دليلٌ آخر وفقًا لـ تشان بأنّ سلوك الولايات المتحدة لا يختلف عن السلوك التعديلي لألمانيا واليابان في السابق.
يرى تشان أنّه بفحص سجّلات تصويت البُلدان في الجمعية العامّة للأمم المتحدّة ومجلس الأمن فسنلاحظ بأنّ واشنطن أصبحت معزولةً بشكلٍ متزايد. فخلال الفترة ما بين 1971 و 2015 كانت نسبة تصويت جميع الدول المصوّتة في الجمعية العامّة لهيئة الأمم المتحدة بـــ “نعم” هي ,175%، في حين كانت 4,7% هي نسبة الدول التّي صوتّت بــــــ “لا” (بقيّة النسبة تُمثّل الدول الممتنعة عن التصويت وعدم المشاركة). صوتّت منها الولايات المتحدة بــ “نعم” بنسبة 21,9%، في حين صوتّت بـــ “لا” بنسبة 54,2%. في نفس الفترة كانت نسبة تصويت الصين بـ “نعم” هي 78,8% و بــ “لا” هي 3,3%. كما لجأت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة كثيرًا إلى استخدام حقّ النقض (The Veto) في مجلس الأمن لعرقلة القرارات التّي عارضتها، وهي قراراتٌ حظيت بتأييد الأغلبية. فما بين شهر أكتوبر 1971 (تاريخ انضمام الصين إلى هيئة الأمم المتحدة) إلى غاية شهر ديسمبر 2019، استخدمت الصين حقّ النقض 14 مرّة، فرنسا 14 مرّة، بريطانيا 24 مرّة، الاتحاد السوفياتي/روسيا 37 مرّة، أمّا الولايات المتحدة فاستخدمت الفيتو 82 مرّةً كاملة. مرّة أخرى يُذكّر تشان عبر هذه المقارنات بأنّ مثل هذه الأنماط من “السلوكات التعديلية” الخارجة عن قواعد المجتمع الدولي لم تبدأ مع إدارة ترامب ولا حتّى مع إدارة جورج بوش الإبن، بل هي ممارسات قديمة للولايات المتحدة.
هكذا، يُمكن تمييز الدلائل التّي تُشير إلى أنّ الولايات المتحدة وجدت نفسها على نحوٍ متزايدٍ خارج قواعد المجتمع الدولي، وتمييز معاييرٍ مُحدّدة كتلك التّي استخدمها باحثون آخرون في السابق لتقييم النزعة التعديلية لبلد ما. يُقارن تشان بين سلوكات بيجين وواشنطن في هذا الصدد لتمييز أيّهما يُعتبر ذا نزعةٍ تعديليةٍ أكثر. تقول بيجين بأنّها تدعم المبادئ الوستفالية لسيادة الدولة وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وسلامة أراضيها، وهي المبادئ التّي تُمثّل المؤسّسات الأساسية للنظام الدولي. هذا لا يعني أنّ الصين قد إلتزمت دائمًا بهذه المبادئ من الناحية العملية، كما هو جلّي في نزاعاتها الخلافية على السيادة في بحر الصين الجنوبي. مع ذلك فقد شاركت خلال العقود الأخيرة في عددٍ أقلّ من الحروب والنزاعات العسكرية مُقارنةً بالولايات المتحدة، حيث تعكس سياستها الحالية بشكلٍ ملحوظٍ تغييرًا هائلاً في خطابها وسلوكها خلال السنوات الماضية عندما دعمت التمرّدات الساعية للإطاحة بالحكومات “البرجوازية” وقاطعت المنظمات الدولية واتبّعت اقتصادًا موجّهًا نحو الداخل يؤكّد الاعتماد على الذات. في المقابل، تطوّرت سياسات الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس. لعبت واشنطن دورًا رائدًا في إنشاء هيئة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعدّدة الأطراف، أمّا الآن فقد تحوّلت إلى منتقدٍ حادٍ لها، كما كانت غائبةً عن ممارسة دورٍ دوليٍ نشطٍ في الأزمات الدولية المعاصرة كالأزمة الماليّة لسنة 2008 وأزمة مكافحة جائحة كوفيد-19.
يستنتج تشان في هذا القسم بأنّ التحوّل من التعدّدية إلى الأحادية أصبح موضع تركيزٍ أكثر حدّةٍ خلال إدارة ترامب. لكن كانت هناك إشاراتٌ سابقةٌ بأنّ الولايات المتحدة كانت تتحرّك في هذا الاتجاه قبل وصول ترامب للحكم. بدا ذلك أكثر وضوحًا في غزوها للعراق دون الحصول على تصريحٍ من هيئة الأمم المتحدة، وأيضًا في هجماتها على صربيا وليبيا وسوريا. كما روّجت واشنطن لعقائدٍ ومبادئٍ جديدةٍ كـ “الحرب الوقائية” و”تغيير النظم السياسية” للدول الأخرى في الخارج وبالتالي فهي تتحدّى بوضوحٍ المؤسّسات الأساسية للنظام الدولي، وهذا ما يُمثّل محاولاتٍ تعديليةٍ لتغيير هذا النظام.
ماذا بخصوص السلوك الصيني السيّء؟
قد يجادل البعض بأنّ الصين لم تلتزم بمعيار سلامة الأراضي ووحدتها وهي تدّعي بحقّها في جزءٍ كبيرٍ من بحر الصين الجنوبي وتواصل خوض نزاعاتٍ إقليميةٍ حول الأراضي مع اليابان والهند. هنا يجيب تشان بأنّ الولايات المتحدة وخلال سنوات صعودها أيضًا استحوذت على مساحاتٍ شاسعةٍ من الأراضي مع هزيمة المكسيك لإسبانيا، ولا يوجد باحثٌ واحدٌ –وفقًا له- اعتبر الولايات المتحدة قوةً تعديليةً بسبب هذا السلوك. عند عقد المقارنات أيضًا بين الولايات المتحدة وغيرها من القوى التعديلية ستبدو عملية الاستحواذ على الأراضي من طرف ألمانيا عمليةً تافهةً في التاريخ. إضافةً إلى ذلك، فقد دعمت الولايات المتحدة عملياتٍ انفصاليةٍ عديدةٍ عبر التاريخ لتوافُقِها مع مصالحها مثلما فعلت حينما دعمت انفصال بنما عن كولومبيا بهدف بناء قناةٍ هناك، أو مساهمتها في تفكيك يوغسلافيا وغيرها الكثير.
تمتلك الصين أكبر عددٍ متقاسَمٍ من الحدود البريّة في العالم مع دولٍ أخرى وقد عرفت تقريبًا جميعها استقرارًا، عادةً ما كان ذلك بشروطٍ مواتيةٍ لجيرانها الصغار. أمّا نزاعاتها الحدودية مع الهند ونيبال فهي الاستثناءات الوحيدة. أمّا بخصوص الحدود البحرية فلديها نزاعاتٌ بحريةٌ مع عدّة دولٍ في بحر الصين الجنوبي، ولا توجد اتفاقيةٌ أُمميّةٌ اتّفق جميع المتنازعين على الرجوع إليها لتحكيم النزاعات. يقتبس تشان عن الباحث والسفير السنغافوري السابق لدى هيئة الأمم المتحدة كيشور محبوباني (Kishore Mahbubani) قوله بأنّ “الصين هي القوة العظمى الوحيدة التّي لم تطلق رصاصةً واحدةً عبر حدودها منذ 30 عامًا” (إلى غاية سنة 2010)، بينما يُلاحظ دافيد كانغ ((David Kang أنّه “على النقيض من ذلك، وحتّى في ظلّ الرئاسة الأمريكية السلمية لباراك أوباما، أسقطت الولايات المتحدة 26 ألف قنبلةٍ على سبع دولٍ في سنة 2016”.
على المستوى التجاري، اتُهِمت الصين باتّباع سياسةٍ تجاريةٍ مُفترسة، مع ذلك أفاد دانيال دريزنر بأنّ “امتثال الصين للأحكام المناوئة لمنظمة التجارة العالمية كان أفضل من امتثال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لها”، ويخلص إلى أنّ “الصين، بعيدًا عن التصرّف كمفسدٍ، تصرّفت في المقام الأول بصفتها صاحبة مصلحةٍ مسؤول من أجل تعزيز الوضع القائم أساسًا للعبة الاقتصادية العالمية”. على النقيض من ذلك، لاحظ بروز (Broz) وزملاؤه بأنّ “الولايات المتحدة استخدمت بشكلٍ متكرّرٍ استثناءات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعات المحليّة من المنافسة الأجنبية أكثر من أيّ دولةٍ أخرى.. قدّمت دولٌ أجنبيةٌ شكاوى في منظمة التجارة العالمية ضدّ الولايات المتحدة لانتهاكها قواعد استثناء التجارة أكثر من أيّ دولةٍ أو منطقة أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي”. لذلك يرى تشان بأنّ ممارسات الصين السيّئة يجب أن تُقرأ على ضوء مقارنتها بالآخرين.
يُقارن تشان أيضًا تدخّل الصين (وروسيا وإيران مثلاً) في الانتخابات الأمريكية لسنتيْ 2016 و2020 -مثلما تدّعي واشنطن- مع السجّل الحافل للتدخّلات الأمريكية منذ عقودٍ طويلةٍ في انتخابات الدول الأخرى عبر العالم وإطاحتها بحكوماتٍ أجنبيةٍ عبر التواطئ في تدبير الانقلابات العسكرية أو انخراطها في غزواتٍ صريحة، مُحاججًا بأنّ الصين لم تكن مرتبطةً على الأقل بمثل هذه الأعمال أو أعمال أخرى كإغتيال علماء نوويّين من دول أخرى. كما يُقارن الكاتب بين نشاطات الجوسسة السيبرانية والقرصنة الأمريكية ونظيرتها الصينية، وأيضًا بين طريقة معاملة الصين لمواطنيها وللأقليّات العرقية داخلها بما يحدث حول العالم في ذات الصدد من انتهاكات حقوق الانسان ومظاهراتٍ عارمةٍ كالمظاهرات التّي رَفعت شعار “حياة السود مهمّة” ويشير إلى أنّ الولايات المتحدة تحاول استخدام ورقة الأقليات وحقوق الإنسان ضدّ الصين اليوم في سياق التنافس القائم بينهما لا غير، فمن المفارقة -مثلما يقول- بأنّ العلاقات الصينية-الأمريكية كانت أكثر وديّةً وتعاونًا خلال سنوات حكم الرؤساء السابقين نيكسون وفورد وكارتر حينما كانت الصين تُحكم من طرف حكومةٍ استبداديةٍ أكثر ممّا هي عليه اليوم، الأمر الذّي يعني –حسبه- بأنّ الانتقادات الأمريكية للصين في هذا السجل مرتبطةٌ بطبيعة العلاقات القائمة بين القوتين (تعاونا أو صراعا)، لا بطبيعة نظام الحكم في الصين.
يختتم تشان هذا القسم بإشارته إلى المعايير المزدوجة والانتقائية التّي تُستخدم عادةً لتقييم ما إذا كانت الدولة تعديليةً أم لا، فكما يقول أنّنا عادةً ما لا نسمع الكثير من الإحالات والإشارات إلى محنة الفلسطينيّين أو الأمريكيّين الأصليّين خلال الحكم على ما إذا كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة دولاً “تعديليةً” اليوم أو كانت كذلك بالأمس.
خاتمة
بعد الحروب النابليونية أنشأت الدول الأوروبية الكبرى وفاق أوروبا "كونسرت اوف اوروبا"للحفاظ على الاستقرار مع السعي للحفاظ على نُظمها المحليّة ونُظمها القائمة. كان النظام الذّي رعته هذه المؤسّسة –وفقًا لجميع الروايات تقريبًا- نظامًا ناجحًا في حفظ السلام في أوروبا. كان هناك عددٌ أقلّ من النزاعات والحروب العسكرية ما بين عاميْ 1816 و 1848 مقارنةً بالفترة ما بين سنتيْ 1849 و 1870 بعد انهيار الوفاق. لم يكن زوال هذا النظام ناتجًا عن رغبة أعضائه الاستبداديّين (بروسيا وروسيا والنمسا والمجر) في تفكيكه، بل نتج عن جهودٍ متعمّدةٍ من قِبل أعضائه الليبراليّين لتقويضه. على سبيل المثال تخلّت فرنسا وبريطانيا عن النظام القائم على هذا الوفاق لإرضاء الرأي العام المحلّي. وبينما أرادت الأنظمة الاستبدادية المحافظة على الوضع القائم وتقديم المساعدة المتبادلة للدفاع عن ممالكها، رأى الأعضاء الليبراليين الأمور بشكلٍ مختلف. يذكر تشارلز كوبشان بأنّ “بريطانيا صارت آنذاك في الواقع قوةً تعديليةً تسعى إلى توسيع نفوذها الجيوبولتيكي وتصدير إيديولوجيتها الليبرالية”.
يجب أن يكون المرء مُدركًا للتحيّز للوضع القائم والذّي غالبًا ما يكون حاضرًا في الخطاب المتعلّق بالنظام الدولي. لا يجب أن يخدم هذا النظام أسباب الحريّة أو العدالة أو المساواة أو كرامة الإنسان. على سبيل المثال، فإنّ النظام المتصوّر في مؤتمر فرساي للسلام الذّي أنهى الحرب العالمية الأولى لم يعترف بمبدأ المساواة العرقية، فقد رفضت الدول الغربية مطالبة اليابان الاعتراف بهذا المبدأ. لم تشمل مثلاً مبادئ ويلسون الأربعة عشر -كحقّ تقرير المصير- الناس في المستعمرات الأوروبية أو في الفلبين التّي كانت مستعمرةً أمريكية.
هل تختلف الولايات المتحدة أو الصين اختلافًا جوهريًا في “نزعتهما التعديلية”؟ يُزعم بأنّ واشنطن تريد الاحتفاظ بصدارتها داخل النظام الحالي فحسب، بينما تريد بيجين استبداله بنظامٍ غير ليبرالي. من الصعب تحديد النوايا، لكنّ السلوك الفعلي أسهل للملاحظة.
منذ نهاية الحرب الباردة انخرطت الولايات المتحدة في برنامجٍ نشطٍ لتغيير الأنظمة وفتحت أسواق البلدان الاشتراكية السابقة ووسعّت نطاق حلف الناتو. لم تُحاول فقط الحفاظ على قيادتها للنظام الغربي المحدود (جغرافيًا وايديولوجيًا) الذّي كان موجودًا خلال الحرب الباردة، ولكنّها سعت بدلاً من ذلك إلى تحقيق هدفٍ أكثر طموحًا لتأسيس نظامٍ عالميٍ جديدٍ يعكس قيمها ومصالحها مثلما يُحاجج جون ميرشايمر. أيْ أنّها كانت قوةً هجوميةً أكثر من كونها قوةً دفاعية. أمّا بيجين فيرى تشان بأنّها –وفقًا لأغلب الباحثين- قد تصرّفت حتّى الآن كصاحب مصلحةٍ مسؤول أكثر من كونها قوةً مُفسدة. يُذّكر تشان مرّةً أخرى بأنّ مشاعر عدم الرضا عن العولمة والدفع باتجاه “الانفصال عن العولمة” جاء من طرف الغرب والولايات المتحدة وليس من طرف الصين، وهذا ما يطرح بدوره سؤالاً عن من يحاول قلب “الهيكل الدولي” أو النظام الدولي أو تعديله. ينتهي الكاتب بتأكيده أنّ السياسة الخارجية لبيجين تعكس بوضوح حقيقة أنّها كانت مستفيدًا كبيرًا من العولمة وأنّ استياء الغرب يرجع لكونه لم ينجح في فعل الشيء نفسه تقريبًا كما فعلت الصين.
-------
عرض وتلخيص للدراسة الأصلية المنشورة في مجلّة الشؤون الدولية، المجلّد 97، العدد 5، سبتمبر 2021، المملكة المتحدّة
*ستيف تشان: هو أستاذ العلوم السياسية بجامعة كولورادو-بولدر، متحصّل على درجة الدكتواره من جامعة مينسوتا الأمريكية سنة 1976، يُعتبر أحد أبرز المنظّرين المعاصرين في العلاقات الدولية، وقد تحصّلت أعماله على العديد من الجوائز العلمية كجائزة كارل دويتش عن جمعية الدراسات الدولية. تهتّم أعمال تشان البحثية بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي والسياسة الخارجية وصنع القرار وشرق آسيا، له عشرين كتابًا ونحو مائة وثمانين مقالاً وفصلاً حول هذه المواضيع. آخر كتبه المنشورة كتاب “هزيم الرعد: تحوّلات القوة وخطر الحرب الصينية-الأمريكية” (ديسمبر، 2022)، “النزعة التعديلية المتنافِسة” (2021)، “فخ ثيوسيديدس؟” (2020) و”الثقة وعدم الثقة في العلاقات الأمريكية-الصينية” (2017).
**جلال خشيب: ∙ باحث مشارك أول بمركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية (CIGA) التابع لجامعة إسطنبول صباح الدّين زعيم بتركيا. تهتّم أعماله البحثية بمجال الجيوبوليتيك، نظريات العلاقات الدولية، سياسات القوى العظمى، جيوبوليتيك أوراسيا وبحر الصين الجنوبي وشمال أفريقيا، السياسة الخارجية التركية والسياسة الخارجية الجزائرية. له العديد من الكتب والدراسات والترجمات والملخصّات الأكاديمية المنشورة منها كتاب “النظام الدولي الليبرالي: جون ميرشايمر في مواجهة جون آيكينبري، صعودٌ أم سقوط؟” (2021) و”أثر التحوّلات الطارئة في بنية النظام الدولي على التوجّهات الكبرى للسياسة الخارجية التركية” (2017) وآفاق الانتقال الديمقراطي في روسيا (2015).
----------
ادراك - سيريا نت


 الصفحات
الصفحات سياسة
سياسة