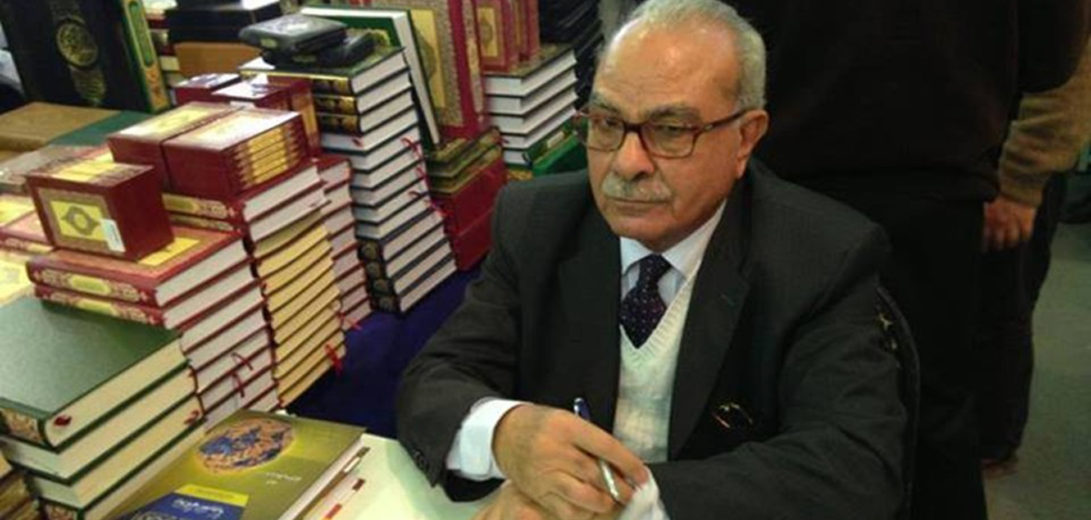عالج عمارة أفكاره بدقة أحيانًا، وبالغ أحيانًا أخرى؛ اقترب من اليسار، واقترب من المعتزلة، واقترب من الإخوان، واقترب من السلفيين، وعمل مع الأزهر برئاسة الشيخ د. أحمد الطيب؛ ولكنه بقي مستقلاً عصاميًّا لا يمكن أن يُحسب على أحد سوى نفسه.
لقد كان له فضل السبق، وفضيلة المواقف الأخلاقية المحترمة، لم يجامل ولم يبدِّل فيما يعتقده حقًّا. كان ثابتًا على مبادئه، خصوصًا أنه زهد في المناصب والأسفار والوظائف التي عافها مبكرًا جدًّا بعد تخرجه ثم طلقها حتى موته.
وفيما يلي حوار أجرِي معه سنة 1431هـ/2010م في إطار إعداد فيلم وثائقي -لصالح قناة الجزيرة- عن سيرته الشخصية ومسيرته الفكرية، ولم يسبق نشر الحوار كاملاً، وقد أدخلِت عليه بعض التعديلات مما يقتضيه تحويل نص الكلام من الشفاهي إلى الكتابي، من دون أي يخلّ ذلك بنصه ومعناه بل ولا بلفظه، مع استثناءات قليلة يفرضها التحرير وسبك الكلام.
1- مرحلة النشأة والتكوين الفكري:
• نشأتَ في أسرة ريفية أميّة؛ فهلا وصفت لنا الأجواء التي نشأت فيها والصعوبات التي واجهتك؟
– وُلدتُ في 27 رجب 1358هـ الموافق 8 ديسمبر/كانون الأول 1931م، في قرية اسمها "سَرَوة" مركز "قلين" في محافظة كفر الشيخ شمالي الدلتا. وُلدت لأسرة ريفية ميسورة الحال، ليست غنية وليست فقيرة تعيش من أرضها، وأنا أمزح فأقول إنني من "السادة"؛ أبي من السادة الفراعنة، وأمي من السادة آل البيت، فالأسرة تجسِّد عناق مصر مع العروبة والإسلام، أنا رابع إخوتي الذكور، والدي قبل أن أولد نذر لله تعالى إذا جاء هذا الحمل ولدًا أن يسميه محمدًا ويهبه للعلم، والعلم في مصطلح القرية في ذلك التاريخ هو العلم الديني.
حدثت لي تجربة في "الكُتّاب" كان فيها قسوة شديدة وعنف، وكان الناس يظنون أن "العريف" أو الشيخ الذي يضرب بشدة هو الذي يعلّم تعليمًا جيدًا. هذا المسلك نفّرني من التعليم، فحاولت أن أشتغل في الفلاحة مثل إخوتي، ولكنْ حَرَص والدي على أن يحقق نذره فقسا عليَّ قسوة أشد من قسوة الكتاب.
انتقلتُ إلى كُتّاب آخر حيث كان يعلمنا فيه شيخ اسمه محمد الجندي عليه رحمة الله. كان أزهريًّا لم يكمل تعليمه، كان بشوشًا فيه ظرف ولطافة، وحينما ذهبت إليه فتح الله علي، وبدأت الأمور تسير في الطريق الصحيح. حفظت القرآن وجودته، وفي نفس الفترة كنت أذهب إلى التعليم الإلزامي، فنتعلم قواعد الحساب وكل هذه الأمور المدنية الحديثة.
في 1945م ذهبت إلى المعهد الديني في مدينة دسوق، وكان في مصر حينها خمسة معاهد: معهد الإسكندرية، ومعهد دسوق، ومعهد طنطا، ومعهد القاهرة، ومعهد أسيوط، والآن فيها أكثر من 8 آلاف معهد. الابتدائي في ذلك التاريخ كان مثل الإعدادي الآن، كنا ندخل أولى ابتدائي بعد حفظ القرآن وتجويده والحساب والإملاء.
وكان الابتدائي في الأزهر في ذلك التاريخ يدرّس علومًا عالية، ففي الصف الرابع الابتدائي كنا ندرس ‘شذور الذهب‘ (= كتاب مرجعي في النحو لابن هشام الأنصاري المتوفى 761هـ/1360م) الذي يدرس في أربع سنوات بكلية الآداب، ما ندرسه في الابتدائي في سنة واحدة كان يُدرس في أربع سنوات في جامعة الملك فؤاد!
فتحت تجربة التعليم الابتدائي أمامي أبوابًا كثيرة، خصوصًا أن الأجواء في الأزهر كانت تتسم بالجمود، وكنا ندرس الحواشي والتعليقات، ولاحظت بعد ذلك أن ما يدرس في الأزهر ليس كتب عصر الازدهار الحضاري ولا كتب عصر التجديد، وإنما كتب في أغلبها مؤلفة في عصر المماليك، لذلك كنا نقوم بإضرابات واعتصامات واحتجاجات مطالبين بإصلاح الأزهر وإدخال اللغات الأجنبية.
• كيف اتجهتَ إلى القراءة من أول الأمر؟ وبمن تأثرت؟
– كنت محظوظًا بعدد من الأساتذة الذين أفادوني إفادة كبيرة كالشيخ عبد الرحمن جلال الذي كان رجلاً صالحًا وفقيها عالما، كان يشجعني على المطالعة، والشيخ محمد كامل الفقي رحمه الله الذي كان الشرارة التي أوقدت فيّ الفكر والقراءة والكتابة، كان سياسيًّا وفْديًّا، نفته الحكومة السعدية في ذلك الوقت إلى دسوق، كان متميزًا كشيخ، أنيقًا يقرأ الصحف والمجلات، وهذا كان غريبا على المشايخ في ذلك التاريخ.
كنا في السنة الثانية الابتدائية وكان يدرّسنا النحو، ويقرأ لنا المقال الافتتاحي في جريدة المصري، دخل ذات يوم وسأل: من منكم يقدر على أن يشتري كتابًا غير الكتب المقررة؟ فذهبت واشتريت كتاب ‘النظرات‘ للمنفلوطي (ت 1924م)، وكان هذا أول كتاب اشتريته في حياتي من خارج الكتب المقررة، قال لي: أحضره معك، وكنت أقرأ وأطالع فيه، وفي آخر العام الدراسي أقمنا حفلة للشيخ وأهدينا له "علبة بنبوني"، وكتبتُ قصيدة شعر في مدحه.
كان في قريتنا عالم اسمه الشيخ عبد التواب الشناوي كان قارئاً وخطيبًا ويتمتع بنوع من الزعامة في القرية، وتخرج في كلية أصول الدين، وشاء الله أن يُتوفى في العام الذي تخرج فيه، وكان عنده مكتبة غنية فيها أربعة آلاف كتاب، وفيها مجلة ‘الأزهر‘ ومجلة ‘الرسالة‘، وكانت فيها النسخة الأصلية لمجلة ‘العروة الوثقى‘، وعيون الفكر الإسلامي وكمٌّ من الكتب المترجمة عن اللغات الأوروبية.
كانت أسرته أميّة مما جعل المكتبة مهملة، فعندما التفتُّ إلى القراءة بدأت أشتري هذه المكتبة، فاشتريت المكتبة بأربعين جنيها (كل كتاب بقرش)، وقد اشتريتها على دفعات، فالمبلغ كان يشتري أرضًا كبيرة وقتها. عكفت على قراءة هذه المكتبة، وخاصة في فترة الإجازة (أربعة أشهر)، فكنت أقرأ حتى تتوه السطور أمام بصري، فأستريح ثم أعاود القراءة. قرأت في هذه المكتبة كتاب ‘نهج البلاغة‘ بشرح الإمام محمد عبده (ت 1905م)، ونظرية [النشوء والارتقاء] لتشارلز داروين (ت 1882م)، وقرأت عن الاشتراكية.
2- الارتباط بالقضية الوطنية والعمل السياسي:
• مارستَ النشاط السياسي في الجامعة، وانضممتَ إلى "مصر الفتاة"؛ فلماذا "مصر الفتاة" وليس "الإخوان المسلمون"؟
– حدث أني التقيت بناسٍ من حزب "مصر الفتاة"، وبدأت العمل بالسياسة من خلال الحركة الوطنية في مصر، ومن خلال القضية الفلسطينية. أول مظاهرة اشتركت فيها كانت سنة 1946 أثناء فترة المعهد (1945-1946)، وكانت مظاهرات ضد مشروع صدقي/بيفن حول الجلاء الإنجليزي عن مصر.
وفي 1947 بدأت أخطب في المساجد ضد اليهود (= الإسرائيليين)، ومن أجل القضية الفلسطينية، وكتبت أول مقال بعنوان "جهاد" عن الفدائيين الذين دخلوا فلسطين قبل الجيوش العربية، نُشر في أول أبريل/نيسان سنة 1948 في جريدة "مصر الفتاة"، وأعتقد أن نشر هذا المقال حدد مستقبلي ومصيري في علاقتي بالكتابة.
كان عندي قلق في هذه المرحلة؛ هل أنتسب إلى الإخوان المسلمين أم مصر الفتاة؟ كان "مصر الفتاة" حزبًا وطنيًّا تقدميًّا إسلاميًّا، وكان الإخوان جماعة إسلامية، وكنت أرى في المنام أحمد حسين (ت 1982م) وحسن البنا (ت 1949م)، ولكن الذي رجح لدي كفة "مصر الفتاة" على كفة "الإخوان المسلمين" أن زملاءنا من الطلبة الذين انتموا إلى الإخوان كان لهم برنامج محدد في القراءة لا يتعدونه، وتحدده لهم الجماعة، وكان عندي نهم في القراءة، فهذا القيد على الحرية في القراءة والاطلاع هو الذي رجح عندي مصر الفتاة.
أضف إلى ذلك أن أبي عليه رحمة الله مرِض، وخاف إذا تُوفي ألا أكمل تعليمي، فكتب لي شرطًا بـمئتيْ جنيه، وكان هذا مبلغًا كبيرًا، وطلب مني تسجيل هذا الشرط في محكمة دسوق، وكان موظف المحكمة يقدم منشورات لمصر الفتاة، وكنت أيضًا أقرأ صحيفة مصر الفتاة، وأعرف أخبار الفدائيين الذين دخلوا من مصر وسوريا إلى فلسطين وذلك قبل دخول الجيوش العربية إلى فلسطين في مايو/أيار سنة 1948.
تحولتُ بعد ذلك إلى الحزب الاشتراكي، مما أتاح لي فرصة لم تتح للكثيرين من جيلي من طلاب التعليم الأزهري؛ فالطالب الأزهري كان يقرأ في التراث، والطالب في التعليم المدني كان يقرأ في الفكر الغربي، أما أنا فأتيحت لي فرصة أن أقرأ في التراث والفكر الغربي معًا.
• في هذه المرحلة كان لديك نزوع ثوري واضح، حتى إنك حاولت أكثر من مرة التدرب على السلاح والانخراط مع الفدائيين في مرحلة مبكرة جدًّا من حياتك؛ كيف حدث ذلك؟
– عندما احتدَّت أحداث القضية الفلسطينية؛ تطوعت لأتدرب على السلاح وأذهب إلى فلسطين، لكن بسبب السن وأن دسوق كانت مدينة صغيرة لم تتح لي فرصة الدخول إلى فلسطين، وعندما ألغيت معاهدة 1936 بين مصر وإنجلترا سنة 1951 تدربت على السلاح أيضًا.
ثم تدربت على السلاح أيضًا للذهاب إلى قناة السويس ومحاربة الجيش الإنجليزي في القواعد العسكرية هناك، لكن حدث حريق القاهرة فأجّلت الموضوع. ولكنني تمكنت من الذهاب إلى القناة لمواجهة العدوان الثلاثي 1956، حين كانت لي علاقة باليسار المصري الذي كان بينه وبين الحكومة تعاون لمواجهة العدوان الثلاثي.
في مرحلة الابتدائي والثانوي -قبل الارتباط باليسار- كانت لدي تجربة في المجاهدة الروحية والتصوف غير الطرقي، وكنت أخطب على المنبر ضد الطرق الصوفية وأعلّم الناس فرائض الدين ومقاومة الظلم، وفي الجمعة التي سبقت ثورة يوليو صادف أن انتقدت الملك فاروق، وعندما عُزل بعد الثورة ظن بعض الناس أنني كنت على علم بتفاصيل ثورة يوليو، وظن آخرون أنني من أولياء الله الصالحين.
وعندما ألغيت الأحزاب -ومنها مصر الفتاة والحزب الاشتراكي- لم يكن أمامنا لمواجهة الإقطاع إلا اليسار، فقد كان اليسار حينها فارس القضية الاجتماعية والعدل الاجتماعي، وكان له موقف من القضية الوطنية؛ فقد كان ضد القواعد العسكرية والوجود الأجنبي. وكنت قد دخلت اليسار من باب القضية الاجتماعية من باب القضية الثورية.
وهناك قضيتان لازمتاني في حياتي -منذ البداية وحتى هذا التاريخ- وهما: قضية الحرية وتحرير الوطن، وقضية العدل الاجتماعي الذي كان يستنفر الإنسان ليقف مع المساكين، وهذا ما جعلني أنتمي إلى اليسار. أتاح لي اليسار أيضًا قراءة الماركسية والفكر الغربي وهذا أضاف لي ولم يخصم مني، كانت هناك أشياء كثيرة في الماركسية أدركت أن لها نظائر في الفكر الإسلامي، كفكرة الجدل والعلاقة بين الظواهر الاجتماعية.
• لماذا أُدخِلتَ إلى السجن، وكيف أثرت فيك هذه التجربة وأنت طالب؟
– كان من تبعات الارتباط باليسار أنني فُصلت من الجامعة لمدة سنة؛ لأنني تزعمت مؤتمرًا وطنيًّا وقوميًّا، كما أنني اعتُقلت نحو ست سنوات، مما أدى إلى تأخر تخرجي إلى 1965 (بدلاً من 1958). وفي فترة السجن والاعتقال -رغم ما كان فيها من تعذيب- عكفت على القراءة والكتابة، كان القلم والورق ممنوعين، ولكن كنا نهربهما عن طريق السجانين، وفي سجن المحاريق بالواحات ترأست فريقًا لعمل مزرعة؛ لأنني فلاح ولي خبرة في الزراعة، وهذا أتاح لي الاتصال بأهالي الواحات.
وفي تلك الفترة كتبت أربع كتب؛ قبل السجن كتبت كتابًا عن القومية العربية ومؤامرات أميركا ضد العرب، حين كنت طالبًا في دار العلوم، كتبته في مواجهة فكر يساري ينكر وجود أمة عربية، وأنا بتراثي الإسلامي أدركت أن الأمة العربية تكونت بظهور الإسلام، فعكفت أسبوعًا وكتبت هذا الكتاب، وكان أول كتاب في مصر ينشر عن القومية العربية بعد الوحدة بين مصر وسوريا، وطُبع طبعتين وتُرجم إلى الروسية. كتبته في 1957 وطُبع في 1958.
وعندما دخلت السجن واستقرت الأمور عكفت على القراءة لتطوير هذه الدراسة، فكتبت كُتُبَ: ‘فجر اليقظة القومية‘، و‘العروبة في العصر الحديث‘، و‘الأمة العربية وقضية الوحدة‘، و‘إسرائيل هل هي سامية؟‘؛ وهي دراسة تقارن بين المشروع الصهيوني والمشروع الصليبي. ونشرت هذه الكتب بعد أن خرجت من السجن.
3- التحولات الفكرية والأيديولوجية:
• كان لديك توجه يساري ونزعة قومية كيف جمعتَ بينهما؟ ثم إنك تقلبت كثيرًا -فيما يبدو- فتنقلتَ بين اليسار والفكر الاشتراكي والمعتزلة والإصلاحية الإسلامية، واتُّهِمتَ بتهم مختلفة منها المادية ثم الاعتزال ثم العقلانية، ثم إنك من ضمن "التراثيين الجدد"، ثم بالسلفية! كيف تنظر إلى هذه التحولات والتصنيفات؟
– دخلت اليسار لأجل القضية الاجتماعية، ولكن بالقراءة والتأمل في السجن أدركت أن حل المشكلة الاجتماعية يكمن في الإسلام، في نظرية الاستخلاف وليس في الصراع الطبقي والماركسية، وهذا هو الذي جعلني -بعد الخروج من السجن 1954 والحصول على الليسانس 1965- أتفرغ للمشروع الفكري منذ منتصف الستينيات. كان ثمة استقطاب حادّ في الحياة الفكرية بين التغريب وبين ما يُسمى السلفية، فكانت الوسطية الإسلامية والتجديد الإسلامي -أي الارتباط بالأصول والجذور مع التجدد- هي التي تشغلني.
مواقفي في مرحلة اليسار والمرحلة القومية ثم الإسلامية حصل فيها نضج وتطور، لكن لم تكن هناك فواصل حادة بينها. كنت يساريًّا بالمعنى الاجتماعي الثوري، وليس بالمعنى العَقَدي فلم يكن هناك إلحاد؛ لأن التجربة الروحية والتكوين الديني الأصيل عصمني من أن أُستوعَب في الفكر المادي والنظرية المادية. عندما أدركت أن حل المشكلة الاجتماعية في الإسلام -وليس في الماركسية- كان هذا بداية النضج في الموقف الإسلامي.
وفي المرحلة الناصرية كان ثمة تركيز على البعد القومي والعربي، وأنا كنت وما زلت أدرك أن القومية دائرة من دوائر الجامعة الإسلامية، فلم يكن هناك تناقض بين الانتصار للوحدة العربية وللقومية العربية وبين الدائرة الإسلامية.
في مرحلة اليسار لا أنكر أنه حدث عندي نوع من الغبش الفكري، ومن سلبيات المرحلة اليسارية -بالنسبة لي- أنني كنت أحفظ دواوين شعرية كثيرة، ثم نسيت هذا في مرحلة اليسار لأنني شغلتني المنشورات والنشاط السياسي، ولكن بدأ الغبش الفكري يزول في المرحلة الإسلامية شيئًا فشيئًا، وبعد 1967 تراجع المشروع القومي وأصبح التركيز على الدائرة الإسلامية.
أيضًا مما عمق موقفي الإسلامي ظهورُ الصحوة الإسلامية في الثمانينيات، وتصاعد التحديات التغريبية للصحوة الإسلامية والحل الإسلامي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في 1991، الأمر الذي جعلني أفرد العديد من الكتب لمواجهة الفكر التغريبي والرد على غلاة العلمانيين، لكن ظلت الدائرة القومية والعربية، وقضية العدل الاجتماعي والثورة على الظلم الاجتماعي ملحوظة في كتاباتي، كما ظلت الدائرة الإنسانية والتفاعل مع الحضارات المختلفة موجودة في مشروعي الفكري.
أما بالنسبة لموضوع المعتزلة؛ فقد كتبت رسالتيْ الماجستير والدكتوراه كشكل من أشكال الهواية، لأنني منذ البداية عزمت ودعوت الله ألا أكون موظَّفًا، وأن أفرغ كل وقتي للعمل الفكري. كتبت الماجستير سنة 1970 عن المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، وما دفعني لهذا -وهي فكرة لا أزال أحتفظ بها- أنني أحتضن كل تراث الأمة، كل فرق الأمة، ولا أتخندق في فرقة معينة أو مذهب معين.
وجدت أن الذين كتبوا عن المعتزلة قبلي كانوا يكتبون عن المعتزلة من كتب خصومهم؛ لأن مخطوطات المعتزلة لم تكن قد اكتُشفت، حتى كارل بروكلمان (ت 1956م) لما كتب ‘تاريخ الأدب العربي‘ لم يكتب عن مخطوطات المعتزلة، وكان أئمة الزيدية قد جمعوا تراث المعتزلة وحبسوه ولم يعرف عنه أحد، وحين ذهبت سنة 1951 -في بعثة من جامعة الدول العربية ودار الكتب المصرية- إلى اليمن اطلعت على تراث المعتزلة المكتَشف حديثًا، وكان للزيدية علاقة بالمعتزلة فحفظوا نصوصهم ومخطوطاتهم.
وكان طه حسين (ت 1973م) قبل ذلك قد اهتم بمخطوطات القاضي عبد الجبار (ت 415هـ/م) فنشر ‘المغني‘ والكثير من هذه الكتب، وكنت أول من أنجز دراسات عُليا في الفكر المعتزلي، وكان عملي إنصافًا للمعتزلة وليس انحيازًا لهم كفرقة من دون سائر الفرق، فقد كتبت أطروحة الدكتوراه عن نظرية الإمامة بين المعتزلة والشيعة وفرق أهل السنة المختلفة.
ثم إن تهمة الاعتزال لا تزال موجودة حتى الآن، ولكنني أقول: أنا لم أتخندق في فرقة، أنصفت المعتزلة كفرسان للعقلانية الإسلامية، وكانوا فرسان نشر الإسلام في الحواضر التي فُتحت وكانت فيها مدارس للفلسفة، فكان لا بد من فكر عقلاني يواجه هذه المدارس.
وفي الوقت الذي كنت أدرس فيه المعتزلة كنت أنشر أعمال رفاعة رافع الطهطاوي (ت 1873م) ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني (ت 1897م) وعبد الرحمن الكواكبي (ت 1902م) وقاسم أمين (ت 1908م) وعلي مبارك (ت 1893م).
أدعو الذين يعتبرون الاعتزال تهمة إلى أن يميزوا بين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد، والتطورات التي حصلت بعد ذلك. وحين أدعو إلى احتضان كل تراث الأمة والانتقاء منه فأنا ضد الهجرة إلى فرقة والتخندق في خندقها أو رفض فرقة؛ فالفكر السلفي فيه أشياء في غاية من العظمة، وعندما اقتربت من ابن تيمية (ت 728هـ/1328م) كتبت عنه وعن عقلانيته، والآن نُسمَّى "العصرانيين الجدد"، ومن قبلُ كنا نُسمَّى "التراثيين الجدد"، وهو اسم أُطلق عليّ وعلى طارق البشري وعادل حسين (ت 2001م).
4- الكتابة والمشروع الفكري:
• لماذا عزمتَ من أول الأمر على أن تكون كاتبًا؟ ما الذي صرفك عما سوى الكتابة مما انشغل به غيرك من الوظائف والمناصب؟
– بدأت النشر في فترة مبكرة منذ كنت في الابتدائية، وهذا أعطاني إحساسًا بأن هذا هو مكاني الطبيعي، فأجمل مكان يوضع فيه اسمي هو صحيفة أو كتاب. فقد كنت أعتبر أن الوظيفة نوع من الرق، وبعد خروجنا من السجن وجد زملائي من اليساريين وظيفة في الصحافة وغيرها بناء على صفقة مع الحكومة، أما أنا فقد تركت اليسار ولذلك لم أعين في هذا المجال، ولكن عينوني في الجمعية الاستهلاكية.
وحين سألت عن سبب ذلك قيل لي: هناك لصوص كثيرون ونحن نريدك أن تمنع السرقة في الجمعية! قلت لهم: ولكن هناك احتمال أن أتحول إلى لص مثلهم! أدركت أن هذه الوظيفة كانت محاولة للقتل المعنوي، كان مرتبي عشرين جنيها، وكنت آخذ إجازة من دون مرتب لأقضي معظم وقتي (18 ساعة) في دار الكتب المصرية (في مرحلة الدراسات العليا)، وفي بعض الأحيان كنت أتقاضى سبعة جنيهات في الشهر بعد اقتطاع فترة الإجازة. وكان والدي يرسل لي الفطير والخبز والسكر والشاي عبر القطار من البلد.
أدركت أنه لا بد من مقاومة هذا القتل المعنوي، خصوصًا أنني حاولت أن أعمل مصحِّحًا في المطبعة ولكنهم رفضوا، وبعد سنتين أو ثلاث طلبت نقلي إلى وزارة الثقافة في التراث في الهيئة العامة للكتاب، وبدأت أشتغل بتحقيق التراث، وأتيحت لي فرصة مراجعة الكتب الإسلامية ذات الحساسية، بمرتب ضعيف جدا.
عُرض عليّ كثيرا أن أذهب إلى الجامعات العربية في دول النفط فرفضت؛ لأن نفسي لم تطاوعني أن أشتغل عند كفيل، ولأن هدفي الأساسي كان التفرغ للعمل الفكري، ومما أعانني على هذا أن زوجتي كانت متفهمة لطموحي الفكري، حتى إنها تركت دراستها العليا في الزراعة وتفرغت للمنزل وحملت أعباءه، ومنزلي عبارة عن مكتبة، كوّنتها من جديد بعد أن نُهبت بعد الاعتقال.
كنت أذهب يوميًا إلى معرض الكتاب لشراء الكتب بالمبالغ التي جمعتها، وقد نمتْ مكتبتي إلى أن غطت جميع جدران المنزل، وكانت زوجتي تسألني: ماذا نفعل بالكتب؟ فأقول لها مداعبًا: سنعلقها في السقف. وُلد أولادي في مكتبة، وكان عندي منهج في تعليم الأولاد أن يتدربوا منذ الصغر على الصورة والورق، وأن تنشأ ألفة بينهم وبين الورق.
• ماذا تعني لك الكتابة؟ وإذا لم تكتب فبماذا تحس؟
– الكتابة بالنسبة لي -كالقراءة والعمل الفكري بشكل عام- رسالة، بل هي أم العبادة. فمكتبي محرابي، وأرى أن الإخلاص لما أعتقده مسألة مبدئية، فالإنسان يجتهد وقد يكون مخطئًا، ولكن المهم هو الإخلاص في طلب الحق. نحن نخوض معركة شرسة وحربًا معلنة على الإسلام، ولذلك أنا أعيش في مواجهة التحديات، وعندي مشاريع كتب أهملتها لسنوات طويلة بسبب هذه التحديات.
• بمن تأثرت؟ هل تأثرتَ بأحد معين في تقنيات الكتابة والتحقيق، خصوصًا أنك دخلت الدراسات العليا من باب الهواية ولم تسلك العمل الأكاديمي؟
– هناك الكثير من الأعلام الذين تأثرت بهم في الجانب الخُلقي والمرابطة الفكرية على ثغور الإسلام، أكثر من تأثري بكتاباتهم؛ فالمدرسة الحديثة التي تأثرت بها تأثرًا شديدًا وانتميت إليها هي مدرسة الإحياء والتجديد، وخاصة الأفغاني وعبده، فقد كان تراثهما نقطة البداية لعملية الإحياء والتجديد في العصر الحديث.
كانت هناك علاقة روحية شديدة بيني وبين الشيخ محمد الغزالي (ت 1996م)، قبل أن أقرأ كتب الشيخ عندما أردت الدفاع عنه ضد الهجوم السلفي عليه. كنت شديد الإعجاب بعباس العقاد (ت 1964م) في إسلامياته وليس في السياسة، وعندما كنت في اليسار كنت أكتب رسائل نقد وهجوم شديد، وكان يرد علي في صحيفة ‘أخبار اليوم‘، كنت أكتب باسم مستعار ويرد عليّ ردودًا عنيفة؛ لأنه كان يساند الملك والإنجليز، فكان جانبه السياسي يجعله أقل مما هو عليه.
كان يعجبني في العقاد عصاميته وعملقته وكبرياؤه، كنت أراه في ميدان التحرير فأكنّ له إعجابًا شديدًا. أيضا أُعجبت بطه حسين، رغم أن الجانب الأدبي عنده أكثر من الجانب الفكري، ولكن مسيرته وكفاحه شكّلا مصادر للإعجاب الفكري بهؤلاء الأعلام.
ومع ذلك لم أتخندق في تراث علَم من هؤلاء، اللهم إلا المجموعة التي عكفت على نشر تراثها وأفكارها (الطهطاوي والأفغاني وعلي مبارك ومحمد عبده وقاسم أمين)، وتعلمت تحقيق الكتب من تحقيق عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ المتوفاة 1998م) لرسائل أبي العلاء المعري (ت 449هـ/1058م).
• هل تتأثر الكتابة لديك بمؤثرات نفسية أو اجتماعية أو خارجية؟ وهل لديك أجواء وطقوس خاصة في الكتابة؟
– أجعل الكتابة بالنسبة لي حائط صد ضد المؤثرات المحيطة، أُغرق نفسي في العمل الفكري كي لا أتأثر بالسلبيات الموجودة في الحياة الاجتماعية والسياسية. طلقت السياسة بالمعنى الدارج (سياسة الدولة) لأن المدرسة الإصلاحية -وبالذات محمد عبده- كانت ترى أن الأمة قبل الدولة والتربية قبل السياسة، وأعيب على الحركات الإسلامية غرقها في السياسة بالمعنى الدارج.
فالعمل الفكري والاستغراق فيه هو علاج حتى للأمراض العضوية التي يعاني منها الإنسان، وإذا كان الصوفية يتحدثون عن الخمر الحلال والسُّكْر الحلال فأنا أرى أن العمل الفكري هو السُّكْر الذي يُبعدك عن منغصات الحياة.
قديمًا كنت أكتب بدون مسوَّدة؛ أحضر مادة الكتاب (الفيش والجذاذات) ثم أكتب، ثم وجدت نفسي مؤخرًا أكتب مسودة أراجعها ثم أبيّضها، وأكتب المسودة على جذاذات صغيرة بقلم جافّ أحمر، ثم أكتب على ورق مسطر جميل، وأعمل له هامش بالمسطرة من الجانبين، وأكتب بقلم حبر أسود لأنني أصوره لاحقًا؛ فالحبر الأسود يبدو أوضح. أكتب صباحًا بعد الإفطار حتى موعد الغداء، ثم أستريح ثم أعاود الكتابة.
في الفترات الماضية كانت الظروف تساعد على الكتابة أكثر، ولكن الظروف الصحية تستدعي التخفيف الآن، رغم أن المشروع الفكري كبير، وكثير من كتبي تتحول إلى مصادر لي، والدربة الكبيرة على استخدام المصادر أصبحت تعين الإنسان، رغم أنني لا أشتغل على الكمبيوتر، ولكن الخبرة في المصادر والمراجع أصبحت تعين الإنسان على أن يصل إلى ما يريد بيسر، لكن البركة كثيرة والحمد لله.
• هل أنت راضٍ عن كل ما كتبته؟
– هناك كتب أدركت أن إعادة طبعها ليست مفيدة وبحاجة إلى إعادة نظر، فهذه أوقفت إعادة طبعها، وأشرت إلى هذا في قائمة كتبي، وهناك أشياء كتبتها لم أُعِدْ النظر فيها إلا أني كتبت ما يصححها.
ففي بعض الأحيان استندت إلى بعض المصادر ثم وجدت أنها لم تكن موثوقة، ككتاب ‘الإمامة والسياسة‘ (المنسوب لابن قتيبة الدِّينَوَري المتوفى 276هـ/889م)، فصححت هذه الكتابات. ولكن المسيرة طويلة؛ فقد بدأت أكتب منذ سنة 1948 ومن الطبيعي أن تتطور الأفكار وتحصل مراجعات في المناهج والأحكام، والذين لا يراجعون أفكارهم هم الموتى!
ولذلك أرى أن المراجعات الفكرية والتطور الفكري ميزة وفضيلة. وبالإضافة إلى ذلك؛ هناك مسألة الأولويات وهي تختلف عن المراجعات، فلكل مرحلة أولوياتها وتحدياتها، في المرحلة القومية كان التركيز على الدائرة العربية أكثر من الدائرة الإسلامية، وفي المرحلة الإسلامية أُدرِجت القومية في إطار الدائرة الإسلامية، ثم تم التركيز على التغريب والغلو العلماني.
• ما أهم الأفكار التي تراجعت عنها؟
– ما كتبته عن الطابع القومي للإسلام؛ كنت أؤكد على أن التوحيد الديني مجرد وجه، ولكن الوجه الآخر هو وحدة الأمة، سبق أن ركزت على الوحدة القومية ولكنني بعد ذلك ركزت على الوحدة الإسلامية، تأثرت بفكرة الصراع الطبقي ثم تبنيت نظرية الاستخلاف ونظرية الأمة، ونظرية التوازن والعدل الاجتماعي والأمن الاجتماعي والتكافل.
• كتبتَ كثيرًا، والكثرة قد لا تكون فضيلة!
– لأني انقطعت انقطاعًا كاملاً لهذا العمل، وكنت أشتغل 18 ساعة كل يوم، ودفعت من الناحية الصحية ثمنًا لذلك: الغضروف والفقرات العنقية وغير ذلك، وأيضًا الانقطاع عن العلاقات الاجتماعية فحتى أقربائي وأولادي يزورونني أكثر مما أزورهم، والناس تعارفت على هذا. وثمة أمر آخر وهو أن كتبي قاربت 240 كتابًا، ولكن منها مئة عبارة عن كتيبات أو مستلات من كتب.
• قد يبدو من كتاباتك الأخيرة أنك أصبحتَ أقرب إلى السلفية، كيف ترى الأمر؟
– كتبت كتيبًا عن ‘سلفية واحدة أم سلفيات‘، وكتبت عنها في كتاب ‘تيارات الفكر الإسلامي‘، وكان محمد عبده يتحدث عن أنه سلفي ويريد فهم الدين كما فهمه سلف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف. كل إنسان سلفي، فكل إنسان له ماضٍ، ولكن ما ماضيك؟ هل هو عصر الازدهار أم عصر التراجع؟ كيف تتعامل مع سلفك؟ هل تهاجر من الحاضر إلى الماضي، أم تستلهم السلف والماضي لقراءة الواقع ولحل مشكلات الواقع؟ ولذلك لدينا سلفيات مختلفة.
لذلك عندما قرأت ابن تيمية في السنوات الأخيرة وجدت عنده أشياء مدهشة، وبعض الذين قرؤوا ما كتبته عن ابن تيمية من السلفيين قالوا لي: مشايخنا لم يقرؤوا ابن تيمية ولم يفهموه! أميّز دائمًا في السلفية بين مرحلة الإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ/855م) ورد الفعل على الفكر اليوناني والغلو الاعتزالي، وبين تطور السلفية عند ابن عقيل الحنبلي (ت 513هـ/1119م) وابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) وابن تيمية وابن القيم (751هـ/1350م).
كما أميّز بين رد الفعل عند الإمام الأشعري (ت 324هـ/936م)، وبين مرحلة تطور الفكر الأشعري عند الإسفراييني (ت 418هـ/1028م) والجويني (ت 478هـ/1085م) والغزالي (ت 505هـ/1111م).
لا بد من الوعي بفكرة تطور المنظومات داخل الفرق الإسلامية، وهي فكرة تجعل الإنسان يبدو سلفيًّا وتقدميًّا؛ فأنا أعتبر نفسي سلفيًّا وتقدميًّا وثوريًّا ومجدِّدًا في وقت واحد، وليس هناك تناقض بين هذه التسميات، لكن لا بد من ضبط من هو سلفك؟ وكيف تتعامل معه؟
• يتهمك البعض بأنك تكرر نفسك كثيرًا، بعض الكتيبات هي مستلات من كتب أخرى، بعض الكتب تتكرر بعناوين مختلفة والمضمون واحد!
– لدي مشروع فكري كبير، والتكرار وارد؛ فعندما أريد أن أكتب عن حسن حنفي مثلاً في كتاب ‘قراءة النص الديني‘ بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي والتأويلات العبثية، وأجد نفسي كتبت عن هذه القضية لدى سعيد العشماوي (ت 2013م)، فيمكن لي أن أستخدم النصوص السابقة مرة أخرى وهذا ليس تكرارًا، ولا أنكر التكرار في الجملة، ولكن إعادة استخدام موادّ سابقة ليس تكبيرًا لحجم المشروع، وإنما هي أشياء طبيعية في العمل الفكري.
• ما أهم كتبك التي تعتبر أن فيها إضافة حقيقية؟
– كتب كثيرة، مثل ‘معالم المنهج الإسلامي‘ الذي يتحدث عن معالم الوسطية الإسلامية، وهو كتاب فريد في بابه؛ وكذلك ما كتبته عن ‘تيارات الفكر الإسلامي‘ وفوضى المصطلحات، وما كتبته عن رد الشبهات عامة، وحول القرآن والسنة، والسماحة وحقوق الإنسان ومكانة المرأة، والسنة والشيعة، والحرب الدينية والجهاد، وما كتبته في مواجهة مشاريع التغريب والغلو التغريبي والغلو العلماني من الرد على نصر أبو زيد (ت 2010م) وحسن حنفي وسعيد العشماوي.
وكذلك ما كتبته عن المعارك الفكرية التي دارت حول الشعر الجاهلي وعلي عبد الرازق (ت 1966م) وحول سلامة موسى (ت 1958م) ومستقبل الثقافة، وعن سيد قطب (ت 1966م) وانتمائه الحضاري القديم عندما رد على كتاب طه حسين ‘مستقبل الثقافة‘ سنة 1938، وفي الرد على تيارات التغريب سواء في تحقيق تراث المدرسة الوسطية الإسلامية (سلسلة "الأعمال الكاملة")، أم في التراث القديم ككتاباتي عن ابن رشد (ت 595هـ/1199م) وتحقيق ‘فصل المقال‘ له، وتحقيق ‘رسائل العدل والتوحيد‘ (= رسائل مختلفة لمجموعة من أئمة المعتزلة)، وهي أعمال اكتشفت من خلالها المساحة المشتركة بين تيارات الفكر الإسلامي.
• ما أهم ملامح هذا المشروع الفكري الذي تتحدث عنه باستمرار؟
– أن نبرز حقيقة الإسلام ومعالمه: العقيدة والشريعة والمنظومة الفكرية، والإحياء الإسلامي للمجتمع، والهداية الإسلامية للإنسان، وعالمية الإسلام، وأيضًا فقه الواقع الذي نعيش فيه وإنزال هذه الأحكام الإسلامية على الواقع الذي نعيش فيه، والتصدي للحرب المعلنة على الإسلام. باختصار: ما هو إسلامنا؟ ما هو الواقع الذي نحن بحاجة إلى فقهه وإلى أسلمته؟ وما التحديات التي تواجه هذا الإسلام؟ هذه هي معالم المشروع الفكري.
• هل ترى في هذا المشروع ميلاً نحو المحافظة بعد أن كنتَ ثوريًّا، وخاصة في المرحلة الأخيرة من حياتك؟
– هذا ليس محافظة؛ فعندما أكتب عن غلاة العلمانية والمتغربين يبدو أنني محافظ، وعندما أكتب في نقد الجمود والتقليد يبدو أنني ثوري وتقدمي؛ هذا موضوع يتعلق بالمجال الذي أكتب فيه، لكن هناك معالم أساسية لا تتغير وهي: الحفاظ على رؤيتي للإسلام ومعالم الإسلام، وعملي الدؤوب لإنهاض وإخراج الأمة من عنق الزجاجة الذي وقعت فيه، ومواجهة التحديات الغربية الشرسة والحرب الصليبية المعلنة على الإسلام.
5- المعارك والخصومات:
• يتهمك البعض أيضًا بأن لديك نزعة انفصالية تجاه الغرب؟
– بالعكس كتبت منذ أكثر من 30 سنة كتاب ‘الغزو الفكري وهم أم حقيقة‘، وقدمت فيه نظرية للعلاقة بين الحضارات، هي ليست من اختراعي ولكنها قراءة لتاريخ هذه العلاقة. ليس هناك أسوار صينية بين الحضارات، فالانغلاق يذيب الشخصية، والتبعية والتقليد تذيب الذات وتمسخها. ولذلك ميزت بين المشترك الإنساني العام، وهذا لا تتغير قوانينه بتغير الحضارات، وبين البصمة الثقافية العقدية والفلسفية وفي الآداب والفنون، فكل حضارة لها بصمتها وتميزها الثقافي.
أنا معجب بسيد قطب عندما يتحدث عن عبقرية الحضارة الغربية في الإبداع المادي، ولذلك أنا لا أقيم قطيعة مع الحضارة الغربية، ولكنني أتحفظ على الجانب المادي والفلسفي والوثني الذي انتقل إلى الحضارة الغربية من الفكر اليوناني، ومن باب أولى الغزو والاستعمار للعالم الإسلامي، فأنا أنادي بالتفاعل بين الحضارات، وأهاجم القطيعة والتبعية.
• كان ثمة هجوم عليك من الكنيسة القبطية، كيف تفسر ذلك؟
– لأن الكنيسة القبطية ساد فيها مشروع عنصري قومي، وقد نشأت لدينا في مصر سنة 1952 جمعية اسمها "الأمة القبطية" تقول: مصر كلها وطننا، اغتصبها العرب والمسلمون قبل أربعة عشر قرنًا، اللغة القبطية هي لغتنا، الإنجيل دستورنا، المسيح زعيمنا.
اختلفت هذه الجماعة مع الكنيسة سنة 1954 فاختطفوا البطريرك ثم قُبض عليهم في أبريل/نيسان من العام نفسه من قبل نظام جمال عبد الناصر (ت 1970م)، وكان منهم البابا شنودة (ت 2012م) الذي دخل الدير في يوليو/تموز 1954 وظهر في 1971 وتبنت الكنيسة هذا المشروع العنصري، ومن هنا بدأت الفتنة الطائفية. لم تكن لدينا في مصر فتنة طائفية قبل مجيء البابا شنودة.
أنا سألت السؤال الذي لم يسأله أحد وهو: لماذا لم تكن بمصر فتنة طائفية قبل مجي البابا شنودة؟ الأمر الذي أغضبهم، وأيضًا لأني كتبت ردودًا على منشورات تنصيرية توزع في مصر، وكتبتها بحكم عضويتي في مجمع البحوث الإسلامية، فالدولة طلبت بيان الحكم الشرعي في هذا، ومجلة "الأزهر" نشرتها في ملحقها.
كتبت عن الفتنة الطائفية والمشروع العنصري الذي يريد إحلال اللغة القبطية محل العربية، والذي يقول بالنص: "إنك إذا قلت للقبطي: إنك عربي فهذه إهانة"، ولذلك أشدتُ بمكرم عبيد (ت 1961م) عندما كتب في ‘الهلال‘ في أبريل/نيسان 1939 "مصريون عرب"، فأثبت عروبة المصريين قبل الفتح الإسلامي، وكان يدافع في المحاكم ويقرأ القرآن ويقول: أنا مسيحي ديانةً مسلم وطنًا.
• كيف تصف لنا علاقتك بالحركة الإسلامية عامة، وبالإخوان خاصة، وقد كنتَ مرتيْن الوسيطَ بين الإخوان والشيخ يوسف القرضاوي، وقدمتَ له عرض التنظيم بأن يكون المرشدَ العام؟
– الإخوان يثقون بي ويحبونني، وأنا أعتبر التنظيم كبرى الحركات الإسلامية، خاصة في ظل حالة التشرذم في الحركة والأحزاب، فليس لدينا رصيد في الشارع إلا الإخوان. سبق أن كتبت نقدًا للحركات ومنهم الإخوان؛ لأنهم ركزوا على السياسة بالمعنى الدارج، وأهملوا المشروع الإصلاحي، كما أهملوا الحديث عن الاحتلال الذي تعيشه الأمة والقواعد العسكرية التي تنتشر في كل بلاد الأمة، والأساطيل التي تنتشر في البحار والمحيطات.
لقد كان له فضل السبق، وفضيلة المواقف الأخلاقية المحترمة، لم يجامل ولم يبدِّل فيما يعتقده حقًّا. كان ثابتًا على مبادئه، خصوصًا أنه زهد في المناصب والأسفار والوظائف التي عافها مبكرًا جدًّا بعد تخرجه ثم طلقها حتى موته.
وفيما يلي حوار أجرِي معه سنة 1431هـ/2010م في إطار إعداد فيلم وثائقي -لصالح قناة الجزيرة- عن سيرته الشخصية ومسيرته الفكرية، ولم يسبق نشر الحوار كاملاً، وقد أدخلِت عليه بعض التعديلات مما يقتضيه تحويل نص الكلام من الشفاهي إلى الكتابي، من دون أي يخلّ ذلك بنصه ومعناه بل ولا بلفظه، مع استثناءات قليلة يفرضها التحرير وسبك الكلام.
1- مرحلة النشأة والتكوين الفكري:
• نشأتَ في أسرة ريفية أميّة؛ فهلا وصفت لنا الأجواء التي نشأت فيها والصعوبات التي واجهتك؟
– وُلدتُ في 27 رجب 1358هـ الموافق 8 ديسمبر/كانون الأول 1931م، في قرية اسمها "سَرَوة" مركز "قلين" في محافظة كفر الشيخ شمالي الدلتا. وُلدت لأسرة ريفية ميسورة الحال، ليست غنية وليست فقيرة تعيش من أرضها، وأنا أمزح فأقول إنني من "السادة"؛ أبي من السادة الفراعنة، وأمي من السادة آل البيت، فالأسرة تجسِّد عناق مصر مع العروبة والإسلام، أنا رابع إخوتي الذكور، والدي قبل أن أولد نذر لله تعالى إذا جاء هذا الحمل ولدًا أن يسميه محمدًا ويهبه للعلم، والعلم في مصطلح القرية في ذلك التاريخ هو العلم الديني.
حدثت لي تجربة في "الكُتّاب" كان فيها قسوة شديدة وعنف، وكان الناس يظنون أن "العريف" أو الشيخ الذي يضرب بشدة هو الذي يعلّم تعليمًا جيدًا. هذا المسلك نفّرني من التعليم، فحاولت أن أشتغل في الفلاحة مثل إخوتي، ولكنْ حَرَص والدي على أن يحقق نذره فقسا عليَّ قسوة أشد من قسوة الكتاب.
انتقلتُ إلى كُتّاب آخر حيث كان يعلمنا فيه شيخ اسمه محمد الجندي عليه رحمة الله. كان أزهريًّا لم يكمل تعليمه، كان بشوشًا فيه ظرف ولطافة، وحينما ذهبت إليه فتح الله علي، وبدأت الأمور تسير في الطريق الصحيح. حفظت القرآن وجودته، وفي نفس الفترة كنت أذهب إلى التعليم الإلزامي، فنتعلم قواعد الحساب وكل هذه الأمور المدنية الحديثة.
في 1945م ذهبت إلى المعهد الديني في مدينة دسوق، وكان في مصر حينها خمسة معاهد: معهد الإسكندرية، ومعهد دسوق، ومعهد طنطا، ومعهد القاهرة، ومعهد أسيوط، والآن فيها أكثر من 8 آلاف معهد. الابتدائي في ذلك التاريخ كان مثل الإعدادي الآن، كنا ندخل أولى ابتدائي بعد حفظ القرآن وتجويده والحساب والإملاء.
وكان الابتدائي في الأزهر في ذلك التاريخ يدرّس علومًا عالية، ففي الصف الرابع الابتدائي كنا ندرس ‘شذور الذهب‘ (= كتاب مرجعي في النحو لابن هشام الأنصاري المتوفى 761هـ/1360م) الذي يدرس في أربع سنوات بكلية الآداب، ما ندرسه في الابتدائي في سنة واحدة كان يُدرس في أربع سنوات في جامعة الملك فؤاد!
فتحت تجربة التعليم الابتدائي أمامي أبوابًا كثيرة، خصوصًا أن الأجواء في الأزهر كانت تتسم بالجمود، وكنا ندرس الحواشي والتعليقات، ولاحظت بعد ذلك أن ما يدرس في الأزهر ليس كتب عصر الازدهار الحضاري ولا كتب عصر التجديد، وإنما كتب في أغلبها مؤلفة في عصر المماليك، لذلك كنا نقوم بإضرابات واعتصامات واحتجاجات مطالبين بإصلاح الأزهر وإدخال اللغات الأجنبية.
• كيف اتجهتَ إلى القراءة من أول الأمر؟ وبمن تأثرت؟
– كنت محظوظًا بعدد من الأساتذة الذين أفادوني إفادة كبيرة كالشيخ عبد الرحمن جلال الذي كان رجلاً صالحًا وفقيها عالما، كان يشجعني على المطالعة، والشيخ محمد كامل الفقي رحمه الله الذي كان الشرارة التي أوقدت فيّ الفكر والقراءة والكتابة، كان سياسيًّا وفْديًّا، نفته الحكومة السعدية في ذلك الوقت إلى دسوق، كان متميزًا كشيخ، أنيقًا يقرأ الصحف والمجلات، وهذا كان غريبا على المشايخ في ذلك التاريخ.
كنا في السنة الثانية الابتدائية وكان يدرّسنا النحو، ويقرأ لنا المقال الافتتاحي في جريدة المصري، دخل ذات يوم وسأل: من منكم يقدر على أن يشتري كتابًا غير الكتب المقررة؟ فذهبت واشتريت كتاب ‘النظرات‘ للمنفلوطي (ت 1924م)، وكان هذا أول كتاب اشتريته في حياتي من خارج الكتب المقررة، قال لي: أحضره معك، وكنت أقرأ وأطالع فيه، وفي آخر العام الدراسي أقمنا حفلة للشيخ وأهدينا له "علبة بنبوني"، وكتبتُ قصيدة شعر في مدحه.
كان في قريتنا عالم اسمه الشيخ عبد التواب الشناوي كان قارئاً وخطيبًا ويتمتع بنوع من الزعامة في القرية، وتخرج في كلية أصول الدين، وشاء الله أن يُتوفى في العام الذي تخرج فيه، وكان عنده مكتبة غنية فيها أربعة آلاف كتاب، وفيها مجلة ‘الأزهر‘ ومجلة ‘الرسالة‘، وكانت فيها النسخة الأصلية لمجلة ‘العروة الوثقى‘، وعيون الفكر الإسلامي وكمٌّ من الكتب المترجمة عن اللغات الأوروبية.
كانت أسرته أميّة مما جعل المكتبة مهملة، فعندما التفتُّ إلى القراءة بدأت أشتري هذه المكتبة، فاشتريت المكتبة بأربعين جنيها (كل كتاب بقرش)، وقد اشتريتها على دفعات، فالمبلغ كان يشتري أرضًا كبيرة وقتها. عكفت على قراءة هذه المكتبة، وخاصة في فترة الإجازة (أربعة أشهر)، فكنت أقرأ حتى تتوه السطور أمام بصري، فأستريح ثم أعاود القراءة. قرأت في هذه المكتبة كتاب ‘نهج البلاغة‘ بشرح الإمام محمد عبده (ت 1905م)، ونظرية [النشوء والارتقاء] لتشارلز داروين (ت 1882م)، وقرأت عن الاشتراكية.
2- الارتباط بالقضية الوطنية والعمل السياسي:
• مارستَ النشاط السياسي في الجامعة، وانضممتَ إلى "مصر الفتاة"؛ فلماذا "مصر الفتاة" وليس "الإخوان المسلمون"؟
– حدث أني التقيت بناسٍ من حزب "مصر الفتاة"، وبدأت العمل بالسياسة من خلال الحركة الوطنية في مصر، ومن خلال القضية الفلسطينية. أول مظاهرة اشتركت فيها كانت سنة 1946 أثناء فترة المعهد (1945-1946)، وكانت مظاهرات ضد مشروع صدقي/بيفن حول الجلاء الإنجليزي عن مصر.
وفي 1947 بدأت أخطب في المساجد ضد اليهود (= الإسرائيليين)، ومن أجل القضية الفلسطينية، وكتبت أول مقال بعنوان "جهاد" عن الفدائيين الذين دخلوا فلسطين قبل الجيوش العربية، نُشر في أول أبريل/نيسان سنة 1948 في جريدة "مصر الفتاة"، وأعتقد أن نشر هذا المقال حدد مستقبلي ومصيري في علاقتي بالكتابة.
كان عندي قلق في هذه المرحلة؛ هل أنتسب إلى الإخوان المسلمين أم مصر الفتاة؟ كان "مصر الفتاة" حزبًا وطنيًّا تقدميًّا إسلاميًّا، وكان الإخوان جماعة إسلامية، وكنت أرى في المنام أحمد حسين (ت 1982م) وحسن البنا (ت 1949م)، ولكن الذي رجح لدي كفة "مصر الفتاة" على كفة "الإخوان المسلمين" أن زملاءنا من الطلبة الذين انتموا إلى الإخوان كان لهم برنامج محدد في القراءة لا يتعدونه، وتحدده لهم الجماعة، وكان عندي نهم في القراءة، فهذا القيد على الحرية في القراءة والاطلاع هو الذي رجح عندي مصر الفتاة.
أضف إلى ذلك أن أبي عليه رحمة الله مرِض، وخاف إذا تُوفي ألا أكمل تعليمي، فكتب لي شرطًا بـمئتيْ جنيه، وكان هذا مبلغًا كبيرًا، وطلب مني تسجيل هذا الشرط في محكمة دسوق، وكان موظف المحكمة يقدم منشورات لمصر الفتاة، وكنت أيضًا أقرأ صحيفة مصر الفتاة، وأعرف أخبار الفدائيين الذين دخلوا من مصر وسوريا إلى فلسطين وذلك قبل دخول الجيوش العربية إلى فلسطين في مايو/أيار سنة 1948.
تحولتُ بعد ذلك إلى الحزب الاشتراكي، مما أتاح لي فرصة لم تتح للكثيرين من جيلي من طلاب التعليم الأزهري؛ فالطالب الأزهري كان يقرأ في التراث، والطالب في التعليم المدني كان يقرأ في الفكر الغربي، أما أنا فأتيحت لي فرصة أن أقرأ في التراث والفكر الغربي معًا.
• في هذه المرحلة كان لديك نزوع ثوري واضح، حتى إنك حاولت أكثر من مرة التدرب على السلاح والانخراط مع الفدائيين في مرحلة مبكرة جدًّا من حياتك؛ كيف حدث ذلك؟
– عندما احتدَّت أحداث القضية الفلسطينية؛ تطوعت لأتدرب على السلاح وأذهب إلى فلسطين، لكن بسبب السن وأن دسوق كانت مدينة صغيرة لم تتح لي فرصة الدخول إلى فلسطين، وعندما ألغيت معاهدة 1936 بين مصر وإنجلترا سنة 1951 تدربت على السلاح أيضًا.
ثم تدربت على السلاح أيضًا للذهاب إلى قناة السويس ومحاربة الجيش الإنجليزي في القواعد العسكرية هناك، لكن حدث حريق القاهرة فأجّلت الموضوع. ولكنني تمكنت من الذهاب إلى القناة لمواجهة العدوان الثلاثي 1956، حين كانت لي علاقة باليسار المصري الذي كان بينه وبين الحكومة تعاون لمواجهة العدوان الثلاثي.
في مرحلة الابتدائي والثانوي -قبل الارتباط باليسار- كانت لدي تجربة في المجاهدة الروحية والتصوف غير الطرقي، وكنت أخطب على المنبر ضد الطرق الصوفية وأعلّم الناس فرائض الدين ومقاومة الظلم، وفي الجمعة التي سبقت ثورة يوليو صادف أن انتقدت الملك فاروق، وعندما عُزل بعد الثورة ظن بعض الناس أنني كنت على علم بتفاصيل ثورة يوليو، وظن آخرون أنني من أولياء الله الصالحين.
وعندما ألغيت الأحزاب -ومنها مصر الفتاة والحزب الاشتراكي- لم يكن أمامنا لمواجهة الإقطاع إلا اليسار، فقد كان اليسار حينها فارس القضية الاجتماعية والعدل الاجتماعي، وكان له موقف من القضية الوطنية؛ فقد كان ضد القواعد العسكرية والوجود الأجنبي. وكنت قد دخلت اليسار من باب القضية الاجتماعية من باب القضية الثورية.
وهناك قضيتان لازمتاني في حياتي -منذ البداية وحتى هذا التاريخ- وهما: قضية الحرية وتحرير الوطن، وقضية العدل الاجتماعي الذي كان يستنفر الإنسان ليقف مع المساكين، وهذا ما جعلني أنتمي إلى اليسار. أتاح لي اليسار أيضًا قراءة الماركسية والفكر الغربي وهذا أضاف لي ولم يخصم مني، كانت هناك أشياء كثيرة في الماركسية أدركت أن لها نظائر في الفكر الإسلامي، كفكرة الجدل والعلاقة بين الظواهر الاجتماعية.
• لماذا أُدخِلتَ إلى السجن، وكيف أثرت فيك هذه التجربة وأنت طالب؟
– كان من تبعات الارتباط باليسار أنني فُصلت من الجامعة لمدة سنة؛ لأنني تزعمت مؤتمرًا وطنيًّا وقوميًّا، كما أنني اعتُقلت نحو ست سنوات، مما أدى إلى تأخر تخرجي إلى 1965 (بدلاً من 1958). وفي فترة السجن والاعتقال -رغم ما كان فيها من تعذيب- عكفت على القراءة والكتابة، كان القلم والورق ممنوعين، ولكن كنا نهربهما عن طريق السجانين، وفي سجن المحاريق بالواحات ترأست فريقًا لعمل مزرعة؛ لأنني فلاح ولي خبرة في الزراعة، وهذا أتاح لي الاتصال بأهالي الواحات.
وفي تلك الفترة كتبت أربع كتب؛ قبل السجن كتبت كتابًا عن القومية العربية ومؤامرات أميركا ضد العرب، حين كنت طالبًا في دار العلوم، كتبته في مواجهة فكر يساري ينكر وجود أمة عربية، وأنا بتراثي الإسلامي أدركت أن الأمة العربية تكونت بظهور الإسلام، فعكفت أسبوعًا وكتبت هذا الكتاب، وكان أول كتاب في مصر ينشر عن القومية العربية بعد الوحدة بين مصر وسوريا، وطُبع طبعتين وتُرجم إلى الروسية. كتبته في 1957 وطُبع في 1958.
وعندما دخلت السجن واستقرت الأمور عكفت على القراءة لتطوير هذه الدراسة، فكتبت كُتُبَ: ‘فجر اليقظة القومية‘، و‘العروبة في العصر الحديث‘، و‘الأمة العربية وقضية الوحدة‘، و‘إسرائيل هل هي سامية؟‘؛ وهي دراسة تقارن بين المشروع الصهيوني والمشروع الصليبي. ونشرت هذه الكتب بعد أن خرجت من السجن.
3- التحولات الفكرية والأيديولوجية:
• كان لديك توجه يساري ونزعة قومية كيف جمعتَ بينهما؟ ثم إنك تقلبت كثيرًا -فيما يبدو- فتنقلتَ بين اليسار والفكر الاشتراكي والمعتزلة والإصلاحية الإسلامية، واتُّهِمتَ بتهم مختلفة منها المادية ثم الاعتزال ثم العقلانية، ثم إنك من ضمن "التراثيين الجدد"، ثم بالسلفية! كيف تنظر إلى هذه التحولات والتصنيفات؟
– دخلت اليسار لأجل القضية الاجتماعية، ولكن بالقراءة والتأمل في السجن أدركت أن حل المشكلة الاجتماعية يكمن في الإسلام، في نظرية الاستخلاف وليس في الصراع الطبقي والماركسية، وهذا هو الذي جعلني -بعد الخروج من السجن 1954 والحصول على الليسانس 1965- أتفرغ للمشروع الفكري منذ منتصف الستينيات. كان ثمة استقطاب حادّ في الحياة الفكرية بين التغريب وبين ما يُسمى السلفية، فكانت الوسطية الإسلامية والتجديد الإسلامي -أي الارتباط بالأصول والجذور مع التجدد- هي التي تشغلني.
مواقفي في مرحلة اليسار والمرحلة القومية ثم الإسلامية حصل فيها نضج وتطور، لكن لم تكن هناك فواصل حادة بينها. كنت يساريًّا بالمعنى الاجتماعي الثوري، وليس بالمعنى العَقَدي فلم يكن هناك إلحاد؛ لأن التجربة الروحية والتكوين الديني الأصيل عصمني من أن أُستوعَب في الفكر المادي والنظرية المادية. عندما أدركت أن حل المشكلة الاجتماعية في الإسلام -وليس في الماركسية- كان هذا بداية النضج في الموقف الإسلامي.
وفي المرحلة الناصرية كان ثمة تركيز على البعد القومي والعربي، وأنا كنت وما زلت أدرك أن القومية دائرة من دوائر الجامعة الإسلامية، فلم يكن هناك تناقض بين الانتصار للوحدة العربية وللقومية العربية وبين الدائرة الإسلامية.
في مرحلة اليسار لا أنكر أنه حدث عندي نوع من الغبش الفكري، ومن سلبيات المرحلة اليسارية -بالنسبة لي- أنني كنت أحفظ دواوين شعرية كثيرة، ثم نسيت هذا في مرحلة اليسار لأنني شغلتني المنشورات والنشاط السياسي، ولكن بدأ الغبش الفكري يزول في المرحلة الإسلامية شيئًا فشيئًا، وبعد 1967 تراجع المشروع القومي وأصبح التركيز على الدائرة الإسلامية.
أيضًا مما عمق موقفي الإسلامي ظهورُ الصحوة الإسلامية في الثمانينيات، وتصاعد التحديات التغريبية للصحوة الإسلامية والحل الإسلامي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في 1991، الأمر الذي جعلني أفرد العديد من الكتب لمواجهة الفكر التغريبي والرد على غلاة العلمانيين، لكن ظلت الدائرة القومية والعربية، وقضية العدل الاجتماعي والثورة على الظلم الاجتماعي ملحوظة في كتاباتي، كما ظلت الدائرة الإنسانية والتفاعل مع الحضارات المختلفة موجودة في مشروعي الفكري.
أما بالنسبة لموضوع المعتزلة؛ فقد كتبت رسالتيْ الماجستير والدكتوراه كشكل من أشكال الهواية، لأنني منذ البداية عزمت ودعوت الله ألا أكون موظَّفًا، وأن أفرغ كل وقتي للعمل الفكري. كتبت الماجستير سنة 1970 عن المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، وما دفعني لهذا -وهي فكرة لا أزال أحتفظ بها- أنني أحتضن كل تراث الأمة، كل فرق الأمة، ولا أتخندق في فرقة معينة أو مذهب معين.
وجدت أن الذين كتبوا عن المعتزلة قبلي كانوا يكتبون عن المعتزلة من كتب خصومهم؛ لأن مخطوطات المعتزلة لم تكن قد اكتُشفت، حتى كارل بروكلمان (ت 1956م) لما كتب ‘تاريخ الأدب العربي‘ لم يكتب عن مخطوطات المعتزلة، وكان أئمة الزيدية قد جمعوا تراث المعتزلة وحبسوه ولم يعرف عنه أحد، وحين ذهبت سنة 1951 -في بعثة من جامعة الدول العربية ودار الكتب المصرية- إلى اليمن اطلعت على تراث المعتزلة المكتَشف حديثًا، وكان للزيدية علاقة بالمعتزلة فحفظوا نصوصهم ومخطوطاتهم.
وكان طه حسين (ت 1973م) قبل ذلك قد اهتم بمخطوطات القاضي عبد الجبار (ت 415هـ/م) فنشر ‘المغني‘ والكثير من هذه الكتب، وكنت أول من أنجز دراسات عُليا في الفكر المعتزلي، وكان عملي إنصافًا للمعتزلة وليس انحيازًا لهم كفرقة من دون سائر الفرق، فقد كتبت أطروحة الدكتوراه عن نظرية الإمامة بين المعتزلة والشيعة وفرق أهل السنة المختلفة.
ثم إن تهمة الاعتزال لا تزال موجودة حتى الآن، ولكنني أقول: أنا لم أتخندق في فرقة، أنصفت المعتزلة كفرسان للعقلانية الإسلامية، وكانوا فرسان نشر الإسلام في الحواضر التي فُتحت وكانت فيها مدارس للفلسفة، فكان لا بد من فكر عقلاني يواجه هذه المدارس.
وفي الوقت الذي كنت أدرس فيه المعتزلة كنت أنشر أعمال رفاعة رافع الطهطاوي (ت 1873م) ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني (ت 1897م) وعبد الرحمن الكواكبي (ت 1902م) وقاسم أمين (ت 1908م) وعلي مبارك (ت 1893م).
أدعو الذين يعتبرون الاعتزال تهمة إلى أن يميزوا بين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد، والتطورات التي حصلت بعد ذلك. وحين أدعو إلى احتضان كل تراث الأمة والانتقاء منه فأنا ضد الهجرة إلى فرقة والتخندق في خندقها أو رفض فرقة؛ فالفكر السلفي فيه أشياء في غاية من العظمة، وعندما اقتربت من ابن تيمية (ت 728هـ/1328م) كتبت عنه وعن عقلانيته، والآن نُسمَّى "العصرانيين الجدد"، ومن قبلُ كنا نُسمَّى "التراثيين الجدد"، وهو اسم أُطلق عليّ وعلى طارق البشري وعادل حسين (ت 2001م).
4- الكتابة والمشروع الفكري:
• لماذا عزمتَ من أول الأمر على أن تكون كاتبًا؟ ما الذي صرفك عما سوى الكتابة مما انشغل به غيرك من الوظائف والمناصب؟
– بدأت النشر في فترة مبكرة منذ كنت في الابتدائية، وهذا أعطاني إحساسًا بأن هذا هو مكاني الطبيعي، فأجمل مكان يوضع فيه اسمي هو صحيفة أو كتاب. فقد كنت أعتبر أن الوظيفة نوع من الرق، وبعد خروجنا من السجن وجد زملائي من اليساريين وظيفة في الصحافة وغيرها بناء على صفقة مع الحكومة، أما أنا فقد تركت اليسار ولذلك لم أعين في هذا المجال، ولكن عينوني في الجمعية الاستهلاكية.
وحين سألت عن سبب ذلك قيل لي: هناك لصوص كثيرون ونحن نريدك أن تمنع السرقة في الجمعية! قلت لهم: ولكن هناك احتمال أن أتحول إلى لص مثلهم! أدركت أن هذه الوظيفة كانت محاولة للقتل المعنوي، كان مرتبي عشرين جنيها، وكنت آخذ إجازة من دون مرتب لأقضي معظم وقتي (18 ساعة) في دار الكتب المصرية (في مرحلة الدراسات العليا)، وفي بعض الأحيان كنت أتقاضى سبعة جنيهات في الشهر بعد اقتطاع فترة الإجازة. وكان والدي يرسل لي الفطير والخبز والسكر والشاي عبر القطار من البلد.
أدركت أنه لا بد من مقاومة هذا القتل المعنوي، خصوصًا أنني حاولت أن أعمل مصحِّحًا في المطبعة ولكنهم رفضوا، وبعد سنتين أو ثلاث طلبت نقلي إلى وزارة الثقافة في التراث في الهيئة العامة للكتاب، وبدأت أشتغل بتحقيق التراث، وأتيحت لي فرصة مراجعة الكتب الإسلامية ذات الحساسية، بمرتب ضعيف جدا.
عُرض عليّ كثيرا أن أذهب إلى الجامعات العربية في دول النفط فرفضت؛ لأن نفسي لم تطاوعني أن أشتغل عند كفيل، ولأن هدفي الأساسي كان التفرغ للعمل الفكري، ومما أعانني على هذا أن زوجتي كانت متفهمة لطموحي الفكري، حتى إنها تركت دراستها العليا في الزراعة وتفرغت للمنزل وحملت أعباءه، ومنزلي عبارة عن مكتبة، كوّنتها من جديد بعد أن نُهبت بعد الاعتقال.
كنت أذهب يوميًا إلى معرض الكتاب لشراء الكتب بالمبالغ التي جمعتها، وقد نمتْ مكتبتي إلى أن غطت جميع جدران المنزل، وكانت زوجتي تسألني: ماذا نفعل بالكتب؟ فأقول لها مداعبًا: سنعلقها في السقف. وُلد أولادي في مكتبة، وكان عندي منهج في تعليم الأولاد أن يتدربوا منذ الصغر على الصورة والورق، وأن تنشأ ألفة بينهم وبين الورق.
• ماذا تعني لك الكتابة؟ وإذا لم تكتب فبماذا تحس؟
– الكتابة بالنسبة لي -كالقراءة والعمل الفكري بشكل عام- رسالة، بل هي أم العبادة. فمكتبي محرابي، وأرى أن الإخلاص لما أعتقده مسألة مبدئية، فالإنسان يجتهد وقد يكون مخطئًا، ولكن المهم هو الإخلاص في طلب الحق. نحن نخوض معركة شرسة وحربًا معلنة على الإسلام، ولذلك أنا أعيش في مواجهة التحديات، وعندي مشاريع كتب أهملتها لسنوات طويلة بسبب هذه التحديات.
• بمن تأثرت؟ هل تأثرتَ بأحد معين في تقنيات الكتابة والتحقيق، خصوصًا أنك دخلت الدراسات العليا من باب الهواية ولم تسلك العمل الأكاديمي؟
– هناك الكثير من الأعلام الذين تأثرت بهم في الجانب الخُلقي والمرابطة الفكرية على ثغور الإسلام، أكثر من تأثري بكتاباتهم؛ فالمدرسة الحديثة التي تأثرت بها تأثرًا شديدًا وانتميت إليها هي مدرسة الإحياء والتجديد، وخاصة الأفغاني وعبده، فقد كان تراثهما نقطة البداية لعملية الإحياء والتجديد في العصر الحديث.
كانت هناك علاقة روحية شديدة بيني وبين الشيخ محمد الغزالي (ت 1996م)، قبل أن أقرأ كتب الشيخ عندما أردت الدفاع عنه ضد الهجوم السلفي عليه. كنت شديد الإعجاب بعباس العقاد (ت 1964م) في إسلامياته وليس في السياسة، وعندما كنت في اليسار كنت أكتب رسائل نقد وهجوم شديد، وكان يرد علي في صحيفة ‘أخبار اليوم‘، كنت أكتب باسم مستعار ويرد عليّ ردودًا عنيفة؛ لأنه كان يساند الملك والإنجليز، فكان جانبه السياسي يجعله أقل مما هو عليه.
كان يعجبني في العقاد عصاميته وعملقته وكبرياؤه، كنت أراه في ميدان التحرير فأكنّ له إعجابًا شديدًا. أيضا أُعجبت بطه حسين، رغم أن الجانب الأدبي عنده أكثر من الجانب الفكري، ولكن مسيرته وكفاحه شكّلا مصادر للإعجاب الفكري بهؤلاء الأعلام.
ومع ذلك لم أتخندق في تراث علَم من هؤلاء، اللهم إلا المجموعة التي عكفت على نشر تراثها وأفكارها (الطهطاوي والأفغاني وعلي مبارك ومحمد عبده وقاسم أمين)، وتعلمت تحقيق الكتب من تحقيق عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ المتوفاة 1998م) لرسائل أبي العلاء المعري (ت 449هـ/1058م).
• هل تتأثر الكتابة لديك بمؤثرات نفسية أو اجتماعية أو خارجية؟ وهل لديك أجواء وطقوس خاصة في الكتابة؟
– أجعل الكتابة بالنسبة لي حائط صد ضد المؤثرات المحيطة، أُغرق نفسي في العمل الفكري كي لا أتأثر بالسلبيات الموجودة في الحياة الاجتماعية والسياسية. طلقت السياسة بالمعنى الدارج (سياسة الدولة) لأن المدرسة الإصلاحية -وبالذات محمد عبده- كانت ترى أن الأمة قبل الدولة والتربية قبل السياسة، وأعيب على الحركات الإسلامية غرقها في السياسة بالمعنى الدارج.
فالعمل الفكري والاستغراق فيه هو علاج حتى للأمراض العضوية التي يعاني منها الإنسان، وإذا كان الصوفية يتحدثون عن الخمر الحلال والسُّكْر الحلال فأنا أرى أن العمل الفكري هو السُّكْر الذي يُبعدك عن منغصات الحياة.
قديمًا كنت أكتب بدون مسوَّدة؛ أحضر مادة الكتاب (الفيش والجذاذات) ثم أكتب، ثم وجدت نفسي مؤخرًا أكتب مسودة أراجعها ثم أبيّضها، وأكتب المسودة على جذاذات صغيرة بقلم جافّ أحمر، ثم أكتب على ورق مسطر جميل، وأعمل له هامش بالمسطرة من الجانبين، وأكتب بقلم حبر أسود لأنني أصوره لاحقًا؛ فالحبر الأسود يبدو أوضح. أكتب صباحًا بعد الإفطار حتى موعد الغداء، ثم أستريح ثم أعاود الكتابة.
في الفترات الماضية كانت الظروف تساعد على الكتابة أكثر، ولكن الظروف الصحية تستدعي التخفيف الآن، رغم أن المشروع الفكري كبير، وكثير من كتبي تتحول إلى مصادر لي، والدربة الكبيرة على استخدام المصادر أصبحت تعين الإنسان، رغم أنني لا أشتغل على الكمبيوتر، ولكن الخبرة في المصادر والمراجع أصبحت تعين الإنسان على أن يصل إلى ما يريد بيسر، لكن البركة كثيرة والحمد لله.
• هل أنت راضٍ عن كل ما كتبته؟
– هناك كتب أدركت أن إعادة طبعها ليست مفيدة وبحاجة إلى إعادة نظر، فهذه أوقفت إعادة طبعها، وأشرت إلى هذا في قائمة كتبي، وهناك أشياء كتبتها لم أُعِدْ النظر فيها إلا أني كتبت ما يصححها.
ففي بعض الأحيان استندت إلى بعض المصادر ثم وجدت أنها لم تكن موثوقة، ككتاب ‘الإمامة والسياسة‘ (المنسوب لابن قتيبة الدِّينَوَري المتوفى 276هـ/889م)، فصححت هذه الكتابات. ولكن المسيرة طويلة؛ فقد بدأت أكتب منذ سنة 1948 ومن الطبيعي أن تتطور الأفكار وتحصل مراجعات في المناهج والأحكام، والذين لا يراجعون أفكارهم هم الموتى!
ولذلك أرى أن المراجعات الفكرية والتطور الفكري ميزة وفضيلة. وبالإضافة إلى ذلك؛ هناك مسألة الأولويات وهي تختلف عن المراجعات، فلكل مرحلة أولوياتها وتحدياتها، في المرحلة القومية كان التركيز على الدائرة العربية أكثر من الدائرة الإسلامية، وفي المرحلة الإسلامية أُدرِجت القومية في إطار الدائرة الإسلامية، ثم تم التركيز على التغريب والغلو العلماني.
• ما أهم الأفكار التي تراجعت عنها؟
– ما كتبته عن الطابع القومي للإسلام؛ كنت أؤكد على أن التوحيد الديني مجرد وجه، ولكن الوجه الآخر هو وحدة الأمة، سبق أن ركزت على الوحدة القومية ولكنني بعد ذلك ركزت على الوحدة الإسلامية، تأثرت بفكرة الصراع الطبقي ثم تبنيت نظرية الاستخلاف ونظرية الأمة، ونظرية التوازن والعدل الاجتماعي والأمن الاجتماعي والتكافل.
• كتبتَ كثيرًا، والكثرة قد لا تكون فضيلة!
– لأني انقطعت انقطاعًا كاملاً لهذا العمل، وكنت أشتغل 18 ساعة كل يوم، ودفعت من الناحية الصحية ثمنًا لذلك: الغضروف والفقرات العنقية وغير ذلك، وأيضًا الانقطاع عن العلاقات الاجتماعية فحتى أقربائي وأولادي يزورونني أكثر مما أزورهم، والناس تعارفت على هذا. وثمة أمر آخر وهو أن كتبي قاربت 240 كتابًا، ولكن منها مئة عبارة عن كتيبات أو مستلات من كتب.
• قد يبدو من كتاباتك الأخيرة أنك أصبحتَ أقرب إلى السلفية، كيف ترى الأمر؟
– كتبت كتيبًا عن ‘سلفية واحدة أم سلفيات‘، وكتبت عنها في كتاب ‘تيارات الفكر الإسلامي‘، وكان محمد عبده يتحدث عن أنه سلفي ويريد فهم الدين كما فهمه سلف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف. كل إنسان سلفي، فكل إنسان له ماضٍ، ولكن ما ماضيك؟ هل هو عصر الازدهار أم عصر التراجع؟ كيف تتعامل مع سلفك؟ هل تهاجر من الحاضر إلى الماضي، أم تستلهم السلف والماضي لقراءة الواقع ولحل مشكلات الواقع؟ ولذلك لدينا سلفيات مختلفة.
لذلك عندما قرأت ابن تيمية في السنوات الأخيرة وجدت عنده أشياء مدهشة، وبعض الذين قرؤوا ما كتبته عن ابن تيمية من السلفيين قالوا لي: مشايخنا لم يقرؤوا ابن تيمية ولم يفهموه! أميّز دائمًا في السلفية بين مرحلة الإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ/855م) ورد الفعل على الفكر اليوناني والغلو الاعتزالي، وبين تطور السلفية عند ابن عقيل الحنبلي (ت 513هـ/1119م) وابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) وابن تيمية وابن القيم (751هـ/1350م).
كما أميّز بين رد الفعل عند الإمام الأشعري (ت 324هـ/936م)، وبين مرحلة تطور الفكر الأشعري عند الإسفراييني (ت 418هـ/1028م) والجويني (ت 478هـ/1085م) والغزالي (ت 505هـ/1111م).
لا بد من الوعي بفكرة تطور المنظومات داخل الفرق الإسلامية، وهي فكرة تجعل الإنسان يبدو سلفيًّا وتقدميًّا؛ فأنا أعتبر نفسي سلفيًّا وتقدميًّا وثوريًّا ومجدِّدًا في وقت واحد، وليس هناك تناقض بين هذه التسميات، لكن لا بد من ضبط من هو سلفك؟ وكيف تتعامل معه؟
• يتهمك البعض بأنك تكرر نفسك كثيرًا، بعض الكتيبات هي مستلات من كتب أخرى، بعض الكتب تتكرر بعناوين مختلفة والمضمون واحد!
– لدي مشروع فكري كبير، والتكرار وارد؛ فعندما أريد أن أكتب عن حسن حنفي مثلاً في كتاب ‘قراءة النص الديني‘ بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي والتأويلات العبثية، وأجد نفسي كتبت عن هذه القضية لدى سعيد العشماوي (ت 2013م)، فيمكن لي أن أستخدم النصوص السابقة مرة أخرى وهذا ليس تكرارًا، ولا أنكر التكرار في الجملة، ولكن إعادة استخدام موادّ سابقة ليس تكبيرًا لحجم المشروع، وإنما هي أشياء طبيعية في العمل الفكري.
• ما أهم كتبك التي تعتبر أن فيها إضافة حقيقية؟
– كتب كثيرة، مثل ‘معالم المنهج الإسلامي‘ الذي يتحدث عن معالم الوسطية الإسلامية، وهو كتاب فريد في بابه؛ وكذلك ما كتبته عن ‘تيارات الفكر الإسلامي‘ وفوضى المصطلحات، وما كتبته عن رد الشبهات عامة، وحول القرآن والسنة، والسماحة وحقوق الإنسان ومكانة المرأة، والسنة والشيعة، والحرب الدينية والجهاد، وما كتبته في مواجهة مشاريع التغريب والغلو التغريبي والغلو العلماني من الرد على نصر أبو زيد (ت 2010م) وحسن حنفي وسعيد العشماوي.
وكذلك ما كتبته عن المعارك الفكرية التي دارت حول الشعر الجاهلي وعلي عبد الرازق (ت 1966م) وحول سلامة موسى (ت 1958م) ومستقبل الثقافة، وعن سيد قطب (ت 1966م) وانتمائه الحضاري القديم عندما رد على كتاب طه حسين ‘مستقبل الثقافة‘ سنة 1938، وفي الرد على تيارات التغريب سواء في تحقيق تراث المدرسة الوسطية الإسلامية (سلسلة "الأعمال الكاملة")، أم في التراث القديم ككتاباتي عن ابن رشد (ت 595هـ/1199م) وتحقيق ‘فصل المقال‘ له، وتحقيق ‘رسائل العدل والتوحيد‘ (= رسائل مختلفة لمجموعة من أئمة المعتزلة)، وهي أعمال اكتشفت من خلالها المساحة المشتركة بين تيارات الفكر الإسلامي.
• ما أهم ملامح هذا المشروع الفكري الذي تتحدث عنه باستمرار؟
– أن نبرز حقيقة الإسلام ومعالمه: العقيدة والشريعة والمنظومة الفكرية، والإحياء الإسلامي للمجتمع، والهداية الإسلامية للإنسان، وعالمية الإسلام، وأيضًا فقه الواقع الذي نعيش فيه وإنزال هذه الأحكام الإسلامية على الواقع الذي نعيش فيه، والتصدي للحرب المعلنة على الإسلام. باختصار: ما هو إسلامنا؟ ما هو الواقع الذي نحن بحاجة إلى فقهه وإلى أسلمته؟ وما التحديات التي تواجه هذا الإسلام؟ هذه هي معالم المشروع الفكري.
• هل ترى في هذا المشروع ميلاً نحو المحافظة بعد أن كنتَ ثوريًّا، وخاصة في المرحلة الأخيرة من حياتك؟
– هذا ليس محافظة؛ فعندما أكتب عن غلاة العلمانية والمتغربين يبدو أنني محافظ، وعندما أكتب في نقد الجمود والتقليد يبدو أنني ثوري وتقدمي؛ هذا موضوع يتعلق بالمجال الذي أكتب فيه، لكن هناك معالم أساسية لا تتغير وهي: الحفاظ على رؤيتي للإسلام ومعالم الإسلام، وعملي الدؤوب لإنهاض وإخراج الأمة من عنق الزجاجة الذي وقعت فيه، ومواجهة التحديات الغربية الشرسة والحرب الصليبية المعلنة على الإسلام.
5- المعارك والخصومات:
• يتهمك البعض أيضًا بأن لديك نزعة انفصالية تجاه الغرب؟
– بالعكس كتبت منذ أكثر من 30 سنة كتاب ‘الغزو الفكري وهم أم حقيقة‘، وقدمت فيه نظرية للعلاقة بين الحضارات، هي ليست من اختراعي ولكنها قراءة لتاريخ هذه العلاقة. ليس هناك أسوار صينية بين الحضارات، فالانغلاق يذيب الشخصية، والتبعية والتقليد تذيب الذات وتمسخها. ولذلك ميزت بين المشترك الإنساني العام، وهذا لا تتغير قوانينه بتغير الحضارات، وبين البصمة الثقافية العقدية والفلسفية وفي الآداب والفنون، فكل حضارة لها بصمتها وتميزها الثقافي.
أنا معجب بسيد قطب عندما يتحدث عن عبقرية الحضارة الغربية في الإبداع المادي، ولذلك أنا لا أقيم قطيعة مع الحضارة الغربية، ولكنني أتحفظ على الجانب المادي والفلسفي والوثني الذي انتقل إلى الحضارة الغربية من الفكر اليوناني، ومن باب أولى الغزو والاستعمار للعالم الإسلامي، فأنا أنادي بالتفاعل بين الحضارات، وأهاجم القطيعة والتبعية.
• كان ثمة هجوم عليك من الكنيسة القبطية، كيف تفسر ذلك؟
– لأن الكنيسة القبطية ساد فيها مشروع عنصري قومي، وقد نشأت لدينا في مصر سنة 1952 جمعية اسمها "الأمة القبطية" تقول: مصر كلها وطننا، اغتصبها العرب والمسلمون قبل أربعة عشر قرنًا، اللغة القبطية هي لغتنا، الإنجيل دستورنا، المسيح زعيمنا.
اختلفت هذه الجماعة مع الكنيسة سنة 1954 فاختطفوا البطريرك ثم قُبض عليهم في أبريل/نيسان من العام نفسه من قبل نظام جمال عبد الناصر (ت 1970م)، وكان منهم البابا شنودة (ت 2012م) الذي دخل الدير في يوليو/تموز 1954 وظهر في 1971 وتبنت الكنيسة هذا المشروع العنصري، ومن هنا بدأت الفتنة الطائفية. لم تكن لدينا في مصر فتنة طائفية قبل مجيء البابا شنودة.
أنا سألت السؤال الذي لم يسأله أحد وهو: لماذا لم تكن بمصر فتنة طائفية قبل مجي البابا شنودة؟ الأمر الذي أغضبهم، وأيضًا لأني كتبت ردودًا على منشورات تنصيرية توزع في مصر، وكتبتها بحكم عضويتي في مجمع البحوث الإسلامية، فالدولة طلبت بيان الحكم الشرعي في هذا، ومجلة "الأزهر" نشرتها في ملحقها.
كتبت عن الفتنة الطائفية والمشروع العنصري الذي يريد إحلال اللغة القبطية محل العربية، والذي يقول بالنص: "إنك إذا قلت للقبطي: إنك عربي فهذه إهانة"، ولذلك أشدتُ بمكرم عبيد (ت 1961م) عندما كتب في ‘الهلال‘ في أبريل/نيسان 1939 "مصريون عرب"، فأثبت عروبة المصريين قبل الفتح الإسلامي، وكان يدافع في المحاكم ويقرأ القرآن ويقول: أنا مسيحي ديانةً مسلم وطنًا.
• كيف تصف لنا علاقتك بالحركة الإسلامية عامة، وبالإخوان خاصة، وقد كنتَ مرتيْن الوسيطَ بين الإخوان والشيخ يوسف القرضاوي، وقدمتَ له عرض التنظيم بأن يكون المرشدَ العام؟
– الإخوان يثقون بي ويحبونني، وأنا أعتبر التنظيم كبرى الحركات الإسلامية، خاصة في ظل حالة التشرذم في الحركة والأحزاب، فليس لدينا رصيد في الشارع إلا الإخوان. سبق أن كتبت نقدًا للحركات ومنهم الإخوان؛ لأنهم ركزوا على السياسة بالمعنى الدارج، وأهملوا المشروع الإصلاحي، كما أهملوا الحديث عن الاحتلال الذي تعيشه الأمة والقواعد العسكرية التي تنتشر في كل بلاد الأمة، والأساطيل التي تنتشر في البحار والمحيطات.
أيضًا الإخوان أهملوا العدل الاجتماعي، رغم أنني حين كتبت عن حسن البنا وجدته يطالب بالإصلاح الزراعي قبل الحزب الشيوعي المصري، وكان لديه برنامج اجتماعي ثوري، وكذلك خاض الشيخ الغزالي معركته ضد الظلم الاجتماعي، وحتى سيد قطب كتب ضد الظلم الاجتماعي، ولكن كل هذا غاب. الإخوان رصيد كبير لا ينبغي أن نفرط فيه، ويجب أن نسانده
• بعد وفاة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله؛ يبدو أنك تحولت إلى فكرة رد الشبهات والدفاع عن الإسلام، وقد استغرق هذا منك الكثير من الجهد، وقد يُفهم هذا على أنه تراجع من البناء إلى الدفاع. ما خلفية هذا التحول؟
– في آخر لقاء بيني وبين الشيخ الغزالي في منزله؛ دخل وأحضر لي آخر كتبه ‘نحو تفسير موضوعي للقرآن الكريم‘، وكتب لي إهداء أحسست أنه يحمّلني الأمانة، كتب لي: "إلى أخي الحبيب د. عمارة داعية الإسلام وحارس تعاليمه. محمد الغزالي"، ثم سافر بعد ذلك إلى الجنادرية (في السعودية)، فتوفي ودُفن هناك في البقيع.
ولي قصة مع الشيخ؛ فقد كنت أسمع به ولم تكن لي به صلة، وكان ثمة معركة بين المشايخ وعبد الرحمن الشرقاوي (ت 1987م) حول كتاباته اليسارية، فألقى الشيخ الغزالي محاضرة في قَطَر عن الغزو الفكري الذي يتمدد في فضائنا، وذكر من بين الأسماء الشرقاوي ومحمد عمارة، ثم حكى الشرقاوي هذا الكلام في مقال له في صحيفة ‘الأهرام‘.
صادف أن قرأت المقال وفيه اسمي، ولكنني لم أتأثر؛ لأنني كنت أحب الغزالي من بعيد، ثم بعد أن قرأ الشيخ مجموعة مقالات لي -ولم يكن قد قرأ لي شيئًا قبلها- أرسل إلي رسالة، وقال لي فيها كلامًا هزني من الأعماق. قال: قالوا لي عنك إنك تفسر الشريعة تفسيرًا ماديًّا، وما كان يليق بمثلي أن يحكم على الرجال من خلال مقالات الآخرين، وإن القليل الذي قرأته لك ردني إلى الصواب في أمرك، ولقد ذهبتُ إلى الذين حدثوني عنك فقلت لهم: هذا عقاد العصر، وهذا وهذا…!
يقودنا هذا إلى الشيخ محمد متولي الشعراوي (ت 1998م) أيضًا؛ فقد كان يدرّس البلاغة في طنطا وأنا طالب، ولم تكن لديه مواهب أكثر من مدرس بلاغة، ثم شاء الله -في حقبة الستينيات عندما علا صوت الفكر المادي- أن يظهر الشعراوي فجأة في مواجهة هذا.
التقيت به في 1992 عندما أقمنا لجنة لعمل صلح بين وزارة الداخلية وجماعات العنف، وتوثقت العلاقة بيننا فكان يعلق عليّ آمالا كبيرة، وفي آخر لقاء بيني وبينه يوم وفاة الشيخ جاد الحق (ت 1996م)، كان الناس يستقبلون المعزين وكان هو يجلس على كرسي، فحين دخلت انتفض واقفًا وعانقني وقبلني ثم رفع يديه إلى السماء وقال: "ربنا يجعل فيك العوض، ربنا يجعل فيك العوض"! أحسست أن جبلاً وُضع على أكتافي!
• عملتَ فترة في الرقابة على الكتب وتقييمها، وكتابة تقارير فيها؛ فهل سبق لك أن أوصيتَ بمصادرة بعض الكتب التي قمتَ بتقييمها؟
– بحكم القانون المصري؛ فإن مجمع البحوث الإسلامية ذو ولاية على الشأن الديني، ولذلك فإن الأعمال الفنية أو الفكرية التي لها علاقة بالإسلام يستشار فيها المجمع، ومنها الكتب الواردة من الخارج، وبحكم عضويتي في المجمع يحيلون إليّ رقابة بعض الكتب. وقد راجعت بعض الكتب التنصيرية، وكنت أول من اقترح الرد عليها لا أن يُكتفى بكتابة تقرير عنها، واقترحت أن تُنشر هذه الردود كملاحق في مجلة ‘الأزهر‘.
وفي هذا الإطار؛ راجعت بعض كتب عبد الكريم سروش، ورغم أنك تختلف معه لكن لا تصادَر كتبه وإنما تُناقش وتُنقد، وكذلك كتب جمال البنا (ت 2013م)، راجعت له ستة كتب أجزت له خمسة منها، والكتاب السادس كان عن المرأة وفيه يتحدث عن أن عورة المرأة هي الثديان، وحتى "المايو البكيني" لا لزوم له! راجعت كذلك كتابًا لسعيد العشماوي عن الأصول المصرية لليهودية، يقدم فيه اليهودية باعتبارها فكرًا مصريًّا لا دينًا، طبعا يكذّب القرآن ويكذّب الروايات القرآنية.
لا أحبذ مصادرة الكتب؛ لأنني أضع نفسي مكان الكاتب، ولي تجربة شخصية في هذا الشأن. ففي الستينيات قدمت كتابي ‘فجر اليقظة القومية‘ إلى "الدار المصرية للتأليف والترجمة" التابعة لوزارة الثقافة، فأجازه المراقب ولكن رئيس مجلس الإدارة لم يكن يريد نشره بسبب خلفيتي اليسارية، فأحاله مجددًا إلى الشيخ أمين الخولي (ت 1966م). وكان لي أحد الأصدقاء من تلامذة الشيخ، فكلمه في شأن الكتاب ولكن الشيخ لم يعجبه الأمر مخافة الشبهة!
ثم ذهبت إلى الشيخ الخولي لأول مرة سنة 1965 فقال لي: أختلف معك في كذا وكذا، لكن لك وجهة نظر، ولديك أسلوب مميز فاحرص عليه. كتب الخولي عن كتابي تقريرًا إيجابيًّا لم يُكتب من قبلُ، وعندما ذهبت إلى الدار المصرية أسألهم عن الكتاب رحبوا بي وقدموا لي قهوة! ولكن رئيس مجلس الإدارة كان مصرًّا على عدم نشره، فأرسله مجددًا إلى مكتب جمال عبد الناصر للشؤون العربية برئاسة حسن صبري الخولي (ت 1985م)، فأحال الكتاب إلى المعهد العالي للدراسات الاشتراكية.
صادف أن من أُحيل إليه الكتاب قرأ كتابي الأول عن القومية العربية وكان معجبًا بأفكاري، فأجاز الكتاب ثم حصلت على مكافأة مئة جنيه. ولكنني كنت قد أنفقتها وأنا أجري وراء الكتاب. ولذلك عندما أفحص الكتب أضع نفسي أمام المؤلف، وبقيت لسنوات طويلة أراجع الكتب الإسلامية في الهيئة العامة للكتاب، وأنقذت مؤلفين من الإهمال كانوا قد شُطبت أسماؤهم؛ ولكنني اكتشفت فيهم عبقرية. مهمتي أن أبدي ملاحظاتي والمؤلف يعيد النظر فيها ثم يُجاز الكتاب. فأنا أحرص على الاحتفاظ بضمير المؤلف والمبدع في التعامل مع الكتب.
– في آخر لقاء بيني وبين الشيخ الغزالي في منزله؛ دخل وأحضر لي آخر كتبه ‘نحو تفسير موضوعي للقرآن الكريم‘، وكتب لي إهداء أحسست أنه يحمّلني الأمانة، كتب لي: "إلى أخي الحبيب د. عمارة داعية الإسلام وحارس تعاليمه. محمد الغزالي"، ثم سافر بعد ذلك إلى الجنادرية (في السعودية)، فتوفي ودُفن هناك في البقيع.
ولي قصة مع الشيخ؛ فقد كنت أسمع به ولم تكن لي به صلة، وكان ثمة معركة بين المشايخ وعبد الرحمن الشرقاوي (ت 1987م) حول كتاباته اليسارية، فألقى الشيخ الغزالي محاضرة في قَطَر عن الغزو الفكري الذي يتمدد في فضائنا، وذكر من بين الأسماء الشرقاوي ومحمد عمارة، ثم حكى الشرقاوي هذا الكلام في مقال له في صحيفة ‘الأهرام‘.
صادف أن قرأت المقال وفيه اسمي، ولكنني لم أتأثر؛ لأنني كنت أحب الغزالي من بعيد، ثم بعد أن قرأ الشيخ مجموعة مقالات لي -ولم يكن قد قرأ لي شيئًا قبلها- أرسل إلي رسالة، وقال لي فيها كلامًا هزني من الأعماق. قال: قالوا لي عنك إنك تفسر الشريعة تفسيرًا ماديًّا، وما كان يليق بمثلي أن يحكم على الرجال من خلال مقالات الآخرين، وإن القليل الذي قرأته لك ردني إلى الصواب في أمرك، ولقد ذهبتُ إلى الذين حدثوني عنك فقلت لهم: هذا عقاد العصر، وهذا وهذا…!
يقودنا هذا إلى الشيخ محمد متولي الشعراوي (ت 1998م) أيضًا؛ فقد كان يدرّس البلاغة في طنطا وأنا طالب، ولم تكن لديه مواهب أكثر من مدرس بلاغة، ثم شاء الله -في حقبة الستينيات عندما علا صوت الفكر المادي- أن يظهر الشعراوي فجأة في مواجهة هذا.
التقيت به في 1992 عندما أقمنا لجنة لعمل صلح بين وزارة الداخلية وجماعات العنف، وتوثقت العلاقة بيننا فكان يعلق عليّ آمالا كبيرة، وفي آخر لقاء بيني وبينه يوم وفاة الشيخ جاد الحق (ت 1996م)، كان الناس يستقبلون المعزين وكان هو يجلس على كرسي، فحين دخلت انتفض واقفًا وعانقني وقبلني ثم رفع يديه إلى السماء وقال: "ربنا يجعل فيك العوض، ربنا يجعل فيك العوض"! أحسست أن جبلاً وُضع على أكتافي!
• عملتَ فترة في الرقابة على الكتب وتقييمها، وكتابة تقارير فيها؛ فهل سبق لك أن أوصيتَ بمصادرة بعض الكتب التي قمتَ بتقييمها؟
– بحكم القانون المصري؛ فإن مجمع البحوث الإسلامية ذو ولاية على الشأن الديني، ولذلك فإن الأعمال الفنية أو الفكرية التي لها علاقة بالإسلام يستشار فيها المجمع، ومنها الكتب الواردة من الخارج، وبحكم عضويتي في المجمع يحيلون إليّ رقابة بعض الكتب. وقد راجعت بعض الكتب التنصيرية، وكنت أول من اقترح الرد عليها لا أن يُكتفى بكتابة تقرير عنها، واقترحت أن تُنشر هذه الردود كملاحق في مجلة ‘الأزهر‘.
وفي هذا الإطار؛ راجعت بعض كتب عبد الكريم سروش، ورغم أنك تختلف معه لكن لا تصادَر كتبه وإنما تُناقش وتُنقد، وكذلك كتب جمال البنا (ت 2013م)، راجعت له ستة كتب أجزت له خمسة منها، والكتاب السادس كان عن المرأة وفيه يتحدث عن أن عورة المرأة هي الثديان، وحتى "المايو البكيني" لا لزوم له! راجعت كذلك كتابًا لسعيد العشماوي عن الأصول المصرية لليهودية، يقدم فيه اليهودية باعتبارها فكرًا مصريًّا لا دينًا، طبعا يكذّب القرآن ويكذّب الروايات القرآنية.
لا أحبذ مصادرة الكتب؛ لأنني أضع نفسي مكان الكاتب، ولي تجربة شخصية في هذا الشأن. ففي الستينيات قدمت كتابي ‘فجر اليقظة القومية‘ إلى "الدار المصرية للتأليف والترجمة" التابعة لوزارة الثقافة، فأجازه المراقب ولكن رئيس مجلس الإدارة لم يكن يريد نشره بسبب خلفيتي اليسارية، فأحاله مجددًا إلى الشيخ أمين الخولي (ت 1966م). وكان لي أحد الأصدقاء من تلامذة الشيخ، فكلمه في شأن الكتاب ولكن الشيخ لم يعجبه الأمر مخافة الشبهة!
ثم ذهبت إلى الشيخ الخولي لأول مرة سنة 1965 فقال لي: أختلف معك في كذا وكذا، لكن لك وجهة نظر، ولديك أسلوب مميز فاحرص عليه. كتب الخولي عن كتابي تقريرًا إيجابيًّا لم يُكتب من قبلُ، وعندما ذهبت إلى الدار المصرية أسألهم عن الكتاب رحبوا بي وقدموا لي قهوة! ولكن رئيس مجلس الإدارة كان مصرًّا على عدم نشره، فأرسله مجددًا إلى مكتب جمال عبد الناصر للشؤون العربية برئاسة حسن صبري الخولي (ت 1985م)، فأحال الكتاب إلى المعهد العالي للدراسات الاشتراكية.
صادف أن من أُحيل إليه الكتاب قرأ كتابي الأول عن القومية العربية وكان معجبًا بأفكاري، فأجاز الكتاب ثم حصلت على مكافأة مئة جنيه. ولكنني كنت قد أنفقتها وأنا أجري وراء الكتاب. ولذلك عندما أفحص الكتب أضع نفسي أمام المؤلف، وبقيت لسنوات طويلة أراجع الكتب الإسلامية في الهيئة العامة للكتاب، وأنقذت مؤلفين من الإهمال كانوا قد شُطبت أسماؤهم؛ ولكنني اكتشفت فيهم عبقرية. مهمتي أن أبدي ملاحظاتي والمؤلف يعيد النظر فيها ثم يُجاز الكتاب. فأنا أحرص على الاحتفاظ بضمير المؤلف والمبدع في التعامل مع الكتب.


 الصفحات
الصفحات سياسة
سياسة