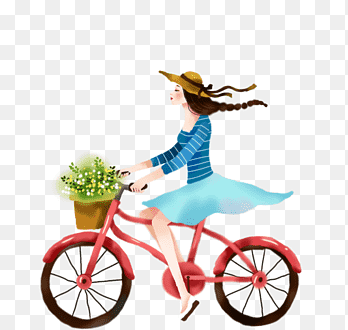لم تمثل تلك الدراجة لي يوماً الذكورة، على العكس تماما كنت أحسها تتقاطع وشخصيتي السريعة العملية، والمنطلقة دائماً
لا أتذكر تحديداً متى امتلكت دراجتي ولكنني لا أتذكر طفولتي بدونها، دراجتي خمرية اللون. كنت من أوائل الفتيات في منطقتي المحببة مصياف، اللواتي تعاملن مع الدراجة بتلك الحميمية. بسببها كنت حرة نفسي دائماً، ولأجلها نشأت بيني وبين مجتمع آخر علاقات غريبة، فأينما كنت وفي أي شارع من شوارع البلدة واضطرت لإعادة ملء العجلات بالهواء فأنا بالتأكيد أعرف أحدهم، في شارع الجوز الذي كان قديماً في حارتي والمؤدي إلى مدرستي الابتدائية كان العم (أبو أحمد) وأخوه يضحكان في وجهي عندما أدخل، والأولوية لي حتماً، ذلك الشارع الذي يعج بأشجار الجوز والرمان وأعشاش النحل، أتخيل أن حجارته تذكرني لو كانت تستطيع الكلام … كبرت قليلاً وخرجت من حارتي باتجاه حارة جدتي (أم سعد)، بالتالي كان علي إيجاد البدائل، فكان العم (حسين) وسيارته الصفراء القديمة جداً باستقبالي بحفاوة، كان يجدني فتاة مسلية أفتح معه الأحاديث وأشرب كأس شاي لحين الانتهاء من أي تصليح …
عرفتني دراجتي على مجتمع وأناس لم أكن أعرفهم وأحياناً لا أتقاطع معهم اجتماعياً، عززت مكانتي الاجتماعية في الحارة والعائلة، فتكونت الكثير من علاقاتي بالصبية في الحارة والمدرسة لتشكيل فرق نقوم بها بالمسابقات والتحديات لدرجة الوصول في مرة اشتد فيها التحدي بيننا إلى قرية (الزينة) الملاصقة لمصياف. في العائلة، وباعتباري الأخت الكبيرة، فقد كنت أضع أخي الصغير أمامي وتقف أختي على المسامير التي تخرج من العجلات الخلفية لتمسك كتفي وننطلق باتجاه أمي إلى العمل، نلقي التحية ونتناول معها الفطور ونكمل مشاويرنا المعتادة. كانت وسيلتي للحركة والسلامات وجلب الأغراض، والأهم الهيام على غير هدى في كثير من المرات في الشوارع التي أعشق.
نشأت تلك العلاقة الخاصة وصرت أُعرَف بها، تلك الفتاة التي تربط شعرها كذيل الحصان وتنطلق، تطورت علاقتنا وجلبت دراجة أكبر وصرت أبحث عن زينتها، أنا التي لا أهتم لموضوع التزيين الشخصي أبداً. كانت تلك المرة الأولى التي أغامر فيها بالذهاب إلى أطراف المدينة، إلى محل (خضر بركات) حيث سمعت بأنه قد جلب زينة حديثة وجديدة. وصلت هناك ودخلت بثقة وعرفت عن نفسي أنني تيما بنت تيسير، قال لي: وماذا تريدين عمو؟ قلت له ما أريد وأعطاني، ومن ثم سألني: وهل يعلم أبوك أنك هنا؟ أجبته: بالطبع!
قررت فور الخروج الذهاب بسرعة لمحل والدي في سوق مصياف الصغير، وبالدراجة طبعاً، لأصل إليه وأخبره بما حدث قبل أن يعلم أنني أكذب، وصلت وسألني: كيف أتيت؟ قلت: بالدراجة وكنت عند محل خضر. انزعج جداً وضرب كفاً بكف قائلاً: إلى متى يا تيما وأنت بدأت بالمرحلة الإعدادية؟
أتذكر يومها أنه دار بيننا حديث طويل؛ هو يقول لي رأيه وأنا أرد عليه برأيي، لم يقنع أحدنا الآخر، قال لي: على الأقل تجنبي النزول إلى هنا، قلت له: ما العيب ومن هو الذي يضع قوانين العيب؟ لماذا أتركها وأنا أحسها جزءاً من شخصيتي؟ استسلم مؤقتاً لإلحاحي، وقال: سنرى فيما بعد، ربما هذه أنت لن تتغيري.
عند وصولي إلى ألمانيا سنة 2020 لزيارة إخوتي، وبنفس الروح الطفولية العابثة طلبت من أخي أن يجهز لي دراجته للركوب وأنا خائفة جداً في أعماقي من الخذلان، خفت أن تخذلني حركتي في الثامنة والثلاثين من عمري وليس المهم هو العمر، المهم أنني لم أركبها منذ عشرين عاماً بالضبط. وضعت قدمي الأولى وفوراً وبنفس الخفة (مع فارق الوزن المهول حالياً) ركبتها، انطلقت بها، لم تخذلني، لم تخذل تلك الطفلة المشتاقة، تجولت بها ما يقارب الساعة وأنا أترك الهواء البارد جداً يداعب كل مسامة في جسمي، عدت للبيت واتصلت بوالدي، قلت: ما زلت ماهرة بالركوب عليها يا أبا تميم“، ضحك في خضم مرضه الأخير وقال لي”: هذه أنت لم تتغيري …
هل حقاً نحن لم نتغير؟
مشيت في شوارع مدينة بريمن الألمانية، لكني لم أجد أي شخص أعرفه، لم أجد من أسلم عليه وأرفع يدي عالياً لأشاور له، لم أجد من أحمل معه أغراضه، لا يوجد محل الفلافل التي أحبها لأتوقف عنده، سرحت بخيالاتي وأخذني الحنين إلى تلك الشوارع … إلى طريق المخّاضة، إلى شارع المساكن، للعشاق، إلى الوراقة، السوق الصغير وطريق القلعة، عدت لشارع الجوز شارع الطفولة، إلى ضحكات الناس التي أعرف وجوهها وتعرفني، إلى السلامات، الحارة والامتعاضات، إلى الاستهزاء والاستنكار في عيون البعض، تغيرت الدنيا حقاً وتغيرنا، ربما لم تتغير تلك الروح الشقية فقط، التي فهمت الآن جيداً معنى حدود التاريخ والجغرافيا والزمن، ولكنها لن تستسلم.
هذا النص ضمن الكتيب الثامن من سلسلة أصوات نسائية في المنفى٬ تجدونه على الموقع:


 الصفحات
الصفحات سياسة
سياسة